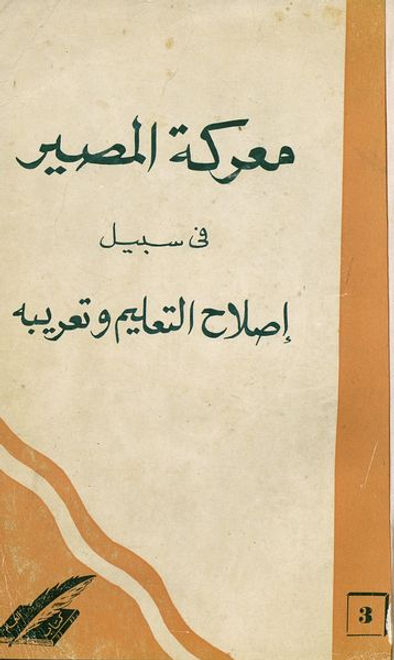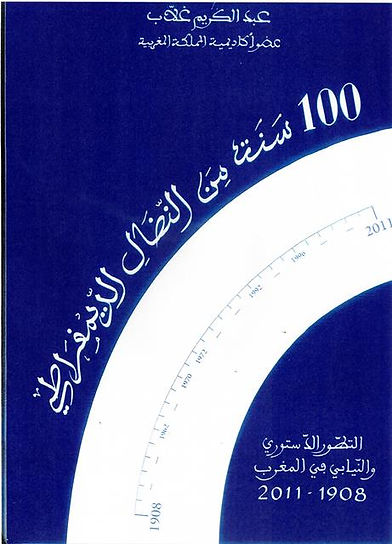1 - سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي والسياسي
تندرج المقالات السياسية لعبد الكريم غلاب ضمن مسار تاريخي ونضالي يمتدّ لأكثر من نصف قرن من الحياة السياسية المغربية. فمنذ أربعينيات القرن الماضي، تميّز بصفته مفكّراً عضوياً في حزب الاستقلال، تَكوَّن في الأوساط الإصلاحية بالمشرق، وتغذّى من الدينامية الوطنية المغربية.
نُشرت هذه النصوص بين خمسينيات القرن العشرين وعام ٢٠١٠، فرافقت التحوّلات الكبرى في تاريخ المغرب المعاصر: الاستقلال، بناء الدولة الحديثة، النقاشات الدستورية المتعاقبة، الإصلاح التربوي واللغوي، ثم الانفتاح الديمقراطي والتحوّلات في القرن الحادي والعشرين.
وتقع هذه المقالات عند تقاطع الفكر السياسي والالتزام الصحفي والتأمل الدستوري، حيث تتحوّل الكتابة الأدبية إلى أداة للتربية المدنية والتعبئة الفكرية.
وهكذا يظهر عبد الكريم غلاب ليس فقط شاهداً حيّاً على المغرب السياسي، بل فاعلاً ومُفكّراً في صياغة الفكر الوطني الحديث.
2 - البنية والمنهج الحِجاجي
تقوم بنية مقالاته على منطق خطابي واضح وتعليمي، غالباً ما يُبنى على ثلاث مراحل:
1. تشخيص المشكلة — أزمة سياسية، انحراف مؤسّساتي أو انحراف أيديولوجي.
2. التحليل النقدي — مقاربة تاريخية وأخلاقية.
3. اقتراح الإصلاح — تقديم بديل يستند إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والوفاء للقيم الوطنية.
الكتابة صارمة لكنها ليست تجريدية. يعتمد عبد الكريم غلاب على منهج استقرائي، ينطلق من الواقع (وقائع، أحداث، أمثلة من المغرب أو من العالم العربي) ليستخلص منها مبادئ عامة.
تسود الخطابَ بلاغةُ الإقناع: جملٌ محكمة البنية، تكرارات أنفورية، ومفردات مدنية قوية مثل «المسؤولية»، «الشعب»، «المؤسسات»، «الأصالة»، «الإصلاح» وغيرها.
وكل نصّ هو في آنٍ واحد تحليلٌ ودعوة إلى الوعي.
3 - الرموز والشخصيات السياسية
رغم خلوّ المقالات من شخصيات متخيّلة، فإنّ عبد الكريم غلاب يُبرز فيها شخصيات رمزية، منها:
-
المواطن المغربي، وريث التقاليد وفاعل التغيير في آنٍ واحد؛
-
المسؤول السياسي، المدعوّ دوماً إلى إعادة تعريف رسالته الأخلاقية؛
-
الشعب، كيان جماعي وأخلاقي في صميم الشرعية السياسية؛
-
ثم شخصيات تاريخية مثل محمد الخامس، علال الفاسي، ومحمد بوستة، بوصفهم نماذج للوطنية والحكمة والإنسانية السياسية.
ومن خلال هذه النماذج، يبني عبد الكريم غلاب معرضا أخلاقيا للسياسة، حيث تغدو المسؤولية والثبات والإخلاص للصالح العام فضائلَ أساسية للسلطة.
وتغدو أعماله السياسية بمثابة أخلاقيات للحُكم، يُقاس فيها رجل الدولة بضميره.
4 - الموضوعات الرئيسة
تتكرّر في هذه المقالات موضوعات تُشكّل بنية فكرية متماسكة:
-
الديمقراطية باعتبارها أفقاً أخلاقياً وتاريخياً للمغرب؛
-
دولة القانون والمؤسسات، في نشأتها وتعطّلاتها وتقدّمها؛
-
الإصلاح — الدستوري، التربوي، اللغوي — شرطاً للتقدّم؛
-
الهوية الوطنية: تفاعل بين الأصالة (*التراث*) والحداثة (*الحداثة*)؛
-
الحوار السياسي: تجاوز التطرّف الأيديولوجي وتحقيق التوازن بين التقليد والعقل؛
-
دور الثقافة السياسية في نضج التجربة الديمقراطية؛
-
العدالة الاجتماعية ومكافحة الفوارق بين الريف والمدينة.
ويكوّن هذا المجموع رؤية وطنية مستنيرة، تتجذّر فيها الحرية السياسية في المسؤولية الأخلاقية والثقافية.
5 - الأسلوب والجمالية الأدبية
يحافظ عبد الكريم غلاب، حتى في مقالاته السياسية، على فصاحة الأديب الكلاسيكي.
فاللغة العربية عنده كثيفة الإيقاع وعميقة الجذور القرآنية، تتخللها إشارات نصّية وتلميحات إلى التراث العربي الإسلامي.
ومع ذلك يزاوج هذا الأسلوب بوضوح صحفي نابع من خبرته الطويلة في الصحافة.
أما الفرنسية، في ترجماته أو تكييفاته، فتبقى متّسمة بالرصانة والوضوح، كتابةٌ متوازنة بلا مبالغة، دافعة دوماً بقناعة أخلاقية.
وبذلك فإن الجمالية الغلابية في السياسة ليست بلاغةً لذاتها، بل توظيفٌ للّغة في خدمة الوعي المدني.
6 - التلقّي النقدي والأثر الفكري
حظيت المقالات السياسية لعبد الكريم غلاب بتقدير واسع — سياسي وأكاديمي وصحفي.
وقد استُشهد بها في أبحاث العلوم السياسية المغربية، خصوصاً تلك المعنية بنشأة النظام البرلماني، كما وردت في دراسات عربية حول الإصلاحية الوطنية.
وفي المغرب، تمثّل هذه المقالات ذاكرة فكرية للحركة الاستقلالية ومرجعاً لفهم تطوّر الحياة الدستورية في البلاد.
وعلى الصعيد العربي، يَبرز عبد الكريم غلاب ضمن مفكّري الإصلاح السياسي في مرحلة ما بعد الاستعمار، إلى جانب مفكرين مصريين وسوريين ومغاربيين.
إن صوته، الهادئ الواثق، يبقى صوت المثقّف الوسيط — لا عقائديّاً ولا تكنوقراطياً، بل خادماً للحوار بين الدولة والمجتمع.
الاستقلالية - عقيدة ومذهب وبرنامج
الطبعة الأولى:
-
نُشر لأول مرة على الأرجح بين عامي 1954 و1956
طبعات أخرى:
-
نُشرت في البداية كمقالات في صحافة حزب الاستقلال، قبل أن تُعاد نشرها في شكل كتاب بواسطة دار الكتاب في الرباط في الخمسينيات.
-
مطبعة أطلس، الرباط (1960)
-
طبعات المعارف الجديدة، الرباط (1964)
-
طبعات لاحقة في مجموعات مختلفة لحزب الاستقلال وفي منشورات اتحاد كتاب المغرب
مقال سياسي رائد، يُحدد فيه عبد الكريم غلاب مبادئ الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي للمغرب ما بعد الاستعمار. يُبرز الكاتب الفكر الإصلاحي للحركة الوطنية، وضرورة بناء دولة قائمة على السيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية.
ملخص :
يتناول الكتاب المعنى العميق لكلمة "استقلال" بعد عام 1956. بالنسبة لعبد الكريم غلاب، لا يقتصر الاستقلال على نهاية الحماية: بل يجب أن يمتد إلى الثقافة والفكر والاقتصاد.
يبدأ الكتاب بتحليل الأسباب التاريخية للاستعمار في المغرب ويدين التبعية الأخلاقية والفكرية التي أحدثها.
ويطالب عبد الكريم غلاب باستقلال كامل، ليس مجرد قطيعة إدارية مع فرنسا، بل مشروع حضاري متجذر في القيم الإسلامية والتقاليد الوطنية، مشروع وطني متماسك تعمل فيه الدولة والمثقفون والشعب معا من أجل إعادة إحياء المغرب الحديث.
ثم يصف وسائل هذا الاستقلال: الإصلاح التعليمي، والتأكيد اللغوي، والسيادة الاقتصادية.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال عشية الاستقلال، وهو يمثل نضوج الخطاب القومي المغربي .
وهو يعكس التحول من المطالب إلى صياغة نموذج سياسي متميز، ويمثل أحد أوائل الكتابات النظرية المغربية التي عبرت عن مفهوم "الاستقلال التام".
ويأتي ذلك ضمن فترة البناء المؤسساتي للمغرب المستقل.
وهو يعكس النقاشات الأيديولوجية بين أنصار الليبرالية وأنصار الاشتراكية المغربية.
2. البنية والسرد
المقالة مُهيكلة في أقسام قصيرة ومُحكمة، تُذكرنا بالخطاب الصحفي، وتجمع بين التظاهر السياسي والتحليل التاريخي بأسلوب تربوي واضح. يتبنى عبد الكريم غلاب نهجًا جدليًا: رصد الاستعمار ← نقد أخلاقي ← اقتراح نموذج بديل.
3. الشخصية والرمزية
"الرجل المستقل" - الشخصية المركزية في النص - يجسد:
-
المواطن المغربي الحر، حامل الكرامة والمسؤولية الجماعية، الواعي والمسؤول عن مصيره الجماعي،
-
الوعي الوطني.
4. المواضيع الرئيسية
-
إنهاء الاستعمار والسيادة.
-
الوحدة الوطنية والهوية الثقافية.
-
دور اللغة العربية كأداة للتحرر الفكري.
-
الإصلاح المؤسسي.
-
الأخلاق السياسية والمسؤولية المدنية.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
أسلوب خطابي حازم، مستوحى غالبًا من اللغة النضالية والخطاب البرلماني، لكنه متجذر في ثقافة كلاسيكية ودينية عميقة. يجمع كتابه بين الصرامة الجدلية والحماس الخطابي. يستخدم عبد الكريم غلاب أسلوبًا صحفيًا متطورًا ، تتخلله التكرارات والتناقضات الثنائية.
- “التبعية / الحرية”،
- "التقليد / الأصالة".
6. الاستقبال النقدي والنطاق
وقد تم استقباله كنص مؤسس للفكر القومي الحديث ، وقد ترك أثرا على الفكر السياسي المغربي، وغذى الخطاب السياسي لحزب الاستقلال، وألهم أجيالا عديدة من الناشطين والمثقفين.
ولا يزال الكتاب يدرس في الأوساط القومية حتى اليوم باعتباره نصا مرجعيا في الفلسفة السياسية لحركة الاستقلال، ويستشهد به في الدراسات حول تشكل الوعي الوطني في المغرب العربي.
خاتمة :
ومن خلال الاستقلالية يضع عبد الكريم غلاب أسس العقيدة السياسية للمغرب المستقل، ويؤسس للاستقلال كقيمة أخلاقية وحضارية قبل أن يكون هدفا سياسيا: استقلال شامل، تغذيه الإيمان والثقافة والعمل المدني.
تدشن هذه المقالة تقليدا من الفكر الإصلاحي المغربي، حيث التحرر لا ينفصل عن الوفاء للتراث الثقافي والديني.
في الإصلاح القروي
نُشر لأول مرة في عام 1959
-
دار الطباعة الجديدة "الرسالة" بالرباط (1961)
طبعات أخرى:
-
طبعات المعرفة الجديدة، الرباط (1965)
-
دار الكتب، الدار البيضاء (1972)
-
منشورات حزب الاستقلال، الدار البيضاء (1978)
-
وكثيرا ما يتم الاستشهاد بهذا العمل في الدراسات حول السياسة الزراعية والتنمية الريفية في المغرب خلال الخمسينيات والستينيات.
يتناول هذا المقال السياسي والاجتماعي والاقتصادي الظروف المعيشية في الريف المغربي بعد الاستقلال. يتناول عبد الكريم غلاب موضوعي التعليم والزراعة، مقدمًا رؤية شاملة للتنمية قائمة على العدالة الاجتماعية في المجتمعات الريفية، والإصلاح الزراعي والتوزيع العادل للأراضي، ودمقرطة المؤسسات الريفية. يُعدّ هذا العمل بيانًا إصلاحيًا ودعوةً للتحديث تحترم القيم الثقافية المغربية.
ملخص :
في هذا النص، يُلاحظ عبد الكريم غلاب الفجوات العميقة بين المناطق الحضرية والريفية. يندد بإرث الإقطاع والاستعمار في الريف، مؤكدًا على ضرورة إصلاح نظام ملكية الأراضي، والتعليم الزراعي، والإدارة المحلية. كما يُشدد على أهمية التعليم، والمشاركة الشعبية، والاكتفاء الذاتي الغذائي، كركائز أساسية للاستقلال الوطني.
تقترح المقالة إطارًا أيديولوجيًا يربط بين الإسلام والقومية والتقدم الاجتماعي.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في أواخر خمسينيات القرن الماضي، في الوقت الذي سعى فيه المغرب المستقل إلى تحديد نموذجه التنموي، وهو يُسهم في النقاش الدائر حول الإصلاح الزراعي والتوازن بين الأصالة والمعاصرة. يخاطب عبد الكريم غلاب الحكومة والشعب على حد سواء، بروح من التعبئة الوطنية. يُواكب هذا النص أولى خطط التنمية الريفية، وينتمي إلى مجموعة من الأدبيات السياسية ذات البعد الاجتماعي.
2. البنية والسرد
يتألف المقال من أقسام تحليلية، تجمع بين الإحصائيات والشهادات والمقترحات الملموسة، ويتبع نهجًا إصلاحيًا وعمليًا. يُبنى عبد الكريم غلاب تحليله على ثلاثة محاور: التشخيص، ومبادئ الإصلاح، والتطبيق العملي.
3. الشخصية والرمزية
هنا، يُصبح "الفلاح المغربي" رمزًا للأمة في طور البناء، ورمزًا لقلب المغرب، وحارسًا لقيمه الروحية والثقافية، ولكنه أيضًا ضحية للتخلف والتهميش. يُضفي عليه عبد الكريم غلاب كرامةً أخلاقيةً وسياسيةً، ويضعه في قلب مشروع التحرر الوطني.
4. المواضيع الرئيسية
-
العدالة الاجتماعية وإصلاح الأراضي
-
التعليم ومحو الأمية في المناطق الريفية
-
دمج العالم الريفي في التنمية الوطنية
-
الإسلام الاجتماعي وقيم المجتمع.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
يظل أسلوب عبد الكريم غلاب مشبعًا بالشعر الوطني والخطاب الإصلاحي. يسعى نثره الواضح والتربوي إلى الإقناع لا إلى الإثبات، مع الحفاظ على صرامة جدلية.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
أُشيد بالمقالة باعتبارها من أوائل المساهمات المغربية في فكر التنمية الذاتية. وقد أثّرت في العديد من النقاشات السياسية حول الإصلاح الزراعي، ولا تزال مرجعًا أساسيًا لفهم رؤية حزب الاستقلال للتقدم الاجتماعي.
خاتمة :
في كتابه "الإصلاح الريفي"، يؤكد عبد الكريم غلاب أن نهضة المغرب تعتمد على كرامة عالمه الريفي: الإصلاح الاجتماعي والعدالة يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب مع التحديث.
يشكل "الإصلاح الريفي" قطعة أساسية من الإصلاح الغلابي : نص سياسي وإنساني في آن واحد، حيث يصبح تحول العالم الريفي رمزا للمغرب الجديد، المخلص لجذوره ولكن المتجه نحو العدالة والحداثة.
هذا هو الدستور
نُشر لأول مرة في عام 1962
-
مجموعة الرسالة للصحافة، الرباط
طبعات أخرى:
-
دار الكتب، الدار البيضاء (1970)
-
منشورات حزب الاستقلال (1982)
مقال قانوني وسياسي يشرح فيه عبد الكريم غلاب نص أول دستور مغربي لسنة 1962. ويقدم فيه المبادئ الأساسية للدولة المغربية الحديثة، ونطاقها الديمقراطي، والمسؤوليات التي تفرضها على المواطنين.
ملخص :
في هذا النص، يتوجه عبد الكريم غلاب إلى عامة الناس لشرح معنى وتداعيات أول دستور للمغرب المستقل. ويؤكد على استمرارية الملكية الوطنية والمؤسسات الحديثة، ويدعو إلى مشاركة شعبية فاعلة في الحياة السياسية. ويرى غلاب أن الدستور عقد أخلاقي وإطار للتقدم الديمقراطي.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا النص بعد فترة وجيزة من صدور دستور عام ١٩٦٢، وهو يُواكب لحظةً محوريةً في التاريخ السياسي المغربي. ويُجسّد سعي عبد الكريم غلاب إلى تثقيف المواطنين بالثقافة الدستورية والوعي المدني.
2. البنية والسرد
تعتمد المقالة على بنية بيداغوجية: فصلاً بعد فصل، يعلق عبد الكريم غلاب على المواد الأساسية في الدستور ويربطها بمبادئ الفكر الوطني.
3. الشخصية والرمزية
وهنا يصبح "المواطن" البطل الحقيقي للنص - المسؤول، المستنير، المدعو إلى فهم القانون الأساسي لبلاده والدفاع عنه.
4. المواضيع الرئيسية
التربية المدنية، الديمقراطية التمثيلية، الملكية الدستورية، حقوق وواجبات المواطنين، توازن القوى.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
لغة واضحة، أقرب إلى لغة الصحافة، لكنها مشبعة بروح وطنية. نجح عبد الكريم غلاب في الجمع بين الصرامة القانونية والحماس الأخلاقي.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
انتشر الكتاب على نطاق واسع في الأوساط التربوية والناشطة داخل حزب الاستقلال. ويظل مرجعًا أساسيًا لفهم التربية الدستورية في المغرب ما بعد الاستعمار.
خاتمة :
بكتاب "هذا هو الدستور"، يُحوّل عبد الكريم غلاب نصًا قانونيًا إلى أداة للتربية الوطنية. يضع الدستور في صميم الوعي المدني، ويضعه في سياق استمرارية النضال من أجل الحرية.
دفاع عن الديمقراطية
نُشر لأول مرة في عام 1966
-
دار الفكر المغربي، طنجة
طبعة أخرى:
-
مطبعة فضالة، المحمدية (1967)
مقال سياسي هام، يُدافع فيه عبد الكريم غلاب عن الديمقراطية كأساس أخلاقي واجتماعي ومؤسسي للدولة المغربية الحديثة. يُبيّن الكاتب أن الديمقراطية ليست نتاجًا غربيًا، بل هي قيمة راسخة في الثقافة الإسلامية والتاريخ الوطني.
ملخص :
يستكشف عبد الكريم غلاب مسألة الديمقراطية من ثلاثة مناظير: الفلسفة السياسية، والممارسة المؤسسية، والمسؤولية المدنية. ويربط بين تراث الشورى ومفهوم المشاركة السياسية الحديث. ويرى غلاب أن الديمقراطية لا تزدهر إلا في إطار أخلاقي وروحي قائم على الإيمان والعدل والتضامن.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
صدر هذا الكتاب عام 1966، في فترة توتر سياسي وتوطيد مؤسساتي، ويمثل انتقالًا من القومية النضالية إلى الفكر السياسي المنظم. وهو جزء من ترسيخ الفكر الديمقراطي المغربي بعد الاستقلال .
2. البنية والسرد
يتألف الكتاب من مقالات تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية: التعريف المفاهيمي للديمقراطية، وتطبيقها في المغرب، وحمايتها من التجاوزات الاستبدادية. يقدم عبد الكريم غلاب حُجة فلسفية وعملية في آن واحد.
3. الشخصية والرمزية
إن "المواطن الحر" هو البطل الضمني للنص، ولم يعد مجرد فاعل سلبي، بل أصبح فاعلاً مستنيراً في الحياة السياسية وضامناً للعدالة.
4. المواضيع الرئيسية
الديمقراطية والإسلام، المشاركة الشعبية، العدالة الاجتماعية، المؤسسات الدستورية، حرية الصحافة ودور الحزب السياسي.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
كتابات عبد الكريم غلاب غزيرة، عقلانية، ومقنعة. حجته تجمع بين لهجة المنبر والفقيه، مدعومة بآيات قرآنية ومراجع تاريخية.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
شكّل كتاب "الدفاع عن الديمقراطية" محور النقاشات الفكرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، واستُشهد به في المؤتمرات السياسية والأكاديمية كنصٍّ أساسيٍّ للخطاب الديمقراطي المغربي.
خاتمة :
في كتابه "دفاع عن الديمقراطية"، يُكرّس عبد الكريم غلاب فكره لبناء إنسانية سياسية مغربية. ويُبيّن أن الديمقراطية ليست ترفًا، بل ضرورة أخلاقية ودينية تُضفي معنىً على الحرية الوطنية.
معركتنا العربية في مواجهة الاستعمار والصهيونية 1
بالشراكة مع:
-
محمد العربي المساري
-
عبد الجبار السحيمي
نُشر لأول مرة في عام 1967
-
مجموعة الرسالة للصحافة، الرباط
طبعات أخرى:
-
دار الكتب، الدار البيضاء (1973)
-
منشورات حزب الاستقلال، الرباط (1984)
في هذه المقالة، المفعمة بالروح التاريخية والنضالية، يُحلل عبد الكريم غلاب التهديد المزدوج الذي يُشكله الاستعمار الغربي والصهيونية على وحدة العالم العربي وسيادته. ويدعو الكاتب إلى تضامن عربي قائم على الوعي التاريخي والإيمان والعدالة.
ملخص :
من خلال تحليل سياسي وأخلاقي لأحداث خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وخاصةً حرب فلسطين وتحرير المغرب العربي من الاستعمار، يقدم عبد الكريم غلاب رؤيته لعالم عربي يقاوم الظلم. ويؤكد أن النضال ضد الصهيونية ليس نضالًا عسكريًا فحسب، بل هو في المقام الأول نضال فكري وروحي - نضال من أجل الكرامة والسيادة.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال بعد حرب الأيام الستة (1967)، وهو يعكس مناخ الاضطراب والتأمل في أسباب الهزيمة العربية. ويُشير إلى تحول عبد الكريم غلاب من القومية المغربية إلى قومية عربية أكثر شمولية.
2. البنية والسرد
يعتمد المقال على بنية جدلية: عرض تاريخي، وتشخيص أخلاقي، ثم دعوة للإصلاح. يجمع السرد بين التحليل الجيوسياسي والتأمل في المسؤولية الجماعية.
3. الشخصية والرمزية
يصبح "الشعب العربي" كيانًا جماعيًا، رمزًا لمجتمع جريح مُقدّر له أن ينهض من جديد. تُصوَّر إسرائيل والقوى الاستعمارية كقوى فوضى أخلاقية.
4. المواضيع الرئيسية
- مناهضة الاستعمار، مناهضة الصهيونية، الوحدة العربية، النهضة الثقافية والروحية، الإصلاح السياسي.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
الكتابة حيوية، خطابية، مشبعة بتوتر أخلاقي ونبوئي. تتأرجح نبرتها بين الصحافة الملتزمة والخطاب الأيديولوجي، دون أن تفقد صرامتها الفكرية.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
نوقش المقال على نطاق واسع في صحافة حزب الاستقلال والأوساط القومية العربية، وساهم في ترسيخ الصوت المغربي في النقاش العربي حول هزيمة 1967 وسبل التجديد.
خاتمة :
في كتابه "معركتنا العربية في مواجهة الاستعمار والصهيونية"، يُوسّع عبد الكريم غلاب آفاق إنسانيته السياسية لتشمل العالم العربي. فهو يربط التحرر الوطني بالتحرر الأخلاقي، والتضامن بالوعي التاريخي.
معركة المصير في سبيل إصلاح التعليم وتعريبه
بالشراكة مع:
-
محمد العربي المساري
-
عبد الجبار السحيمي
-
مقدمة بقلم علال الفاسي
نُشر لأول مرة في عام 1967
-
مجموعة الرسالة للصحافة، الرباط
طبعات أخرى:
-
دار الكتب، الدار البيضاء (1968)
-
منشورات حزب الاستقلال، الرباط (1976، 1983)
يُعد هذا المقال من أهم نصوص عبد الكريم غلاب السياسية والتربوية. يتناول قضية التعليم المحورية في المغرب المستقل، مُحللاً الرهانات الأيديولوجية والثقافية والاجتماعية لإصلاح المدارس وتعريبها.
ملخص :
في كتابه "معركة المصير في سبيل إصلاح التعليم وتعريبه"، يُقدّم عبد الكريم غلاب التعليمَ باعتباره الساحةَ الحاسمةَ في تحديد مصير الأمة. ويُحدّد العقباتَ الموروثةَ عن الاستعمار - التبعية اللغوية، والنظام النخبوي، والانقسام الاجتماعي - ويدعو إلى نظامٍ مدرسيٍّ وطنيٍّ حديثٍ وموحّدٍ، متجذّرٍ في اللغة والقيم العربية. ويُجادل غلاب بأنّ التعريب ليس خيارًا لغويًا فحسب، بل هو فعلٌ من أفعال السيادة الثقافية.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في ستينيات القرن الماضي، عندما كان المغرب يشرع في أولى إصلاحاته التعليمية بعد الاستقلال، وهو جزء من نقاش أوسع حول اللغة والسياسة التعليمية. وهو يتماشى مع الفكر الإصلاحي الوطني الذي أطلقه علال الفاسي.
2. البنية والسرد
يتوزع الكتاب على ثلاثة محاور: تشخيص للنظام الاستعماري، ونقد للتبعية اللغوية، واقتراح إصلاح شامل قائم على الهوية المغربية والعدالة الاجتماعية. أسلوب الكتابة تحليلي وتعبوي في آن واحد.
3. الشخصية والرمزية
يحتل الشباب المغربي مكانةً محوريةً، فهم يجسدون مصير البلاد ووعدها ومسؤوليتها تجاه مستقبلها. وتُصبح المدرسة رمزًا لمعركة الكرامة والحداثة.
4. المواضيع الرئيسية
الإصلاح التربوي، التعريب، السيادة الثقافية، العدالة الاجتماعية، محاربة الاغتراب الفكري، استمرارية المشروع القومي بعد الاستقلال.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
تتميز المقالة بنبرتها العاطفية والجدالية. يمزج أسلوب عبد الكريم غلاب بين الخطاب السياسي والتربية المدنية والتأمل الأخلاقي. وتساعد الاقتباسات القرآنية والإشارات الفلسفية على الارتقاء بالنقاش إلى ما هو أبعد من مجرد أسلوب أكاديمي.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
أثّر هذا العمل بعمق على الفكر التربوي المغربي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وألهم أجيالًا من المثقفين والقادة السياسيين بربطه إصلاح المدارس بالنهضة الثقافية الوطنية.
خاتمة :
يُجسّد النضال من أجل إصلاح التعليم وتعريبه رؤية عبد الكريم غلاب: التعليم أساس المشروع الوطني، ورافعة الهوية الحرة والمبدعة. وبوضعه اللغة العربية في صميم الإصلاح، أكّد غلاب على استمرارية النضال من أجل الاستقلال والنضال من أجل السيادة الفكرية.
التطور الدستوري والنيابي في المغرب
من سنة 1908 إلى 1977
نُشر لأول مرة في عام 1978
-
مطابع و نشر الدار البيضاء
طبعة أخرى:
-
دار الكتب، الرباط (1984، 1992)
هذه المقالة، من أشمل مقالات عبد الكريم غلاب، تتتبع ما يقرب من سبعة عقود من التاريخ السياسي والمؤسسي للمغرب، من بدايات الحركة الدستورية في أوائل القرن العشرين إلى تأسيس البرلمان الحديث بعد الاستقلال. ويُقدم عبد الكريم غلاب تحليلاً تاريخياً وسياسياً وقانونياً ضمنها.
ملخص :
يقدم عبد الكريم غلاب قراءةً تسلسليةً لعملية البناء الدستوري في المغرب: من المطالب الإصلاحية الأولى عام 1908 إلى دستور عام 1972 والتجربة البرلمانية في سبعينيات القرن الماضي. ويُبيّن أن المغرب شهد استمرارية تاريخية فريدة بين التقليد الملكي والحداثة المؤسسية، موائمًا بين الشرعية الدينية والسلالية والديمقراطية.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في وقتٍ كان المغرب يُرسّخ فيه تجربته البرلمانية، وهو يعكس وجهة نظر مثقّف ملتزم يسعى إلى وضع التطور السياسي الوطني في سياق تاريخي طويل الأمد. ويُعدّ وثيقةً أساسيةً لفهم نشأة الدستورية المغربية.
2. البنية والسرد
يتمحور الكتاب حول ثلاث فترات رئيسية:
-
فترة ما قبل الاستعمار والتطلعات الأولى للإصلاح (1908-1912)؛
-
عصر الحماية والنضال من أجل مشروع سياسي وطني (1912-1956)؛
-
الدولة المستقلة والتأسيس التدريجي للمؤسسات التمثيلية (1956-1977).
-
يتناوب النغمة بين صرامة الفيلم الوثائقي والدعوة السياسية.
3. الشخصية والرمزية
البطل الجماعي هنا هو الشعب المغربي، صاحب الشرعية السياسية. أما الملكية، فتُوصف بأنها الضامن للاستمرارية الوطنية واستقرار الإصلاحات.
4. المواضيع الرئيسية
-
البناء الدستوري للمغرب الحديث؛
-
تطور النظام البرلماني؛
-
جدلية بين التقليد والحداثة السياسية؛
-
المشاركة الشعبية والشرعية الملكية؛
-
تحديات التعددية والتمثيلية
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
يجمع كتاب عبد الكريم غلاب بين رصانة التحليل التاريخي وحماسة المناضل. يبقى أسلوبه واضحًا ومنهجيًا، تتخلله مقاطع شعرية تكشف عن فخر شاهد على التاريخ الوطني.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
حظي هذا الكتاب بإشادة الأوساط الأكاديمية والسياسية باعتباره مساهمة أساسية في فهم الحياة المؤسسية المغربية. ولا يزال يُستشهد به في أعمال القانون الدستوري والتاريخ السياسي المعاصر.
خاتمة :
في مقاله "التطور الدستوري والنيابي في المغرب: من عام 1908 إلى عام 1977"، يضع عبد الكريم غلاب مسار المغرب في سياق الحداثة السياسية العالمية، مسلطًا الضوء على خصائصها الفريدة. ويوضح المقال قناعته بأن الديمقراطية المغربية يجب أن تُبنى على تاريخها وتقاليدها الدينية ونظامها الملكي الإصلاحي.
الفكر التقدمي في الأيديولوجية التقدمية
نُشر لأول مرة في عام 1979
-
مجموعة الرسالة للصحافة، الرباط
طبعات أخرى:
-
منشورات حزب الاستقلال، الرباط (1980)
-
دار الكتب، الدار البيضاء (1986، 1994)
يُقدّم هذا المقال تصور عبد الكريم غلاب للفكر التقدمي، مُؤسِّسًا إياه على الواقع المغربي والعربي بدلًا من النماذج المستوردة. وهو نصٌّ برمجيٌّ وعقائديٌّ يسعى فيه غلاب إلى إعادة تعريف مفهوم التقدم في ضوء القيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية.
ملخص :
يُقدّم عبد الكريم غلاب تأملاً حول معنى التقدم في السياق المغربي ما بعد الاستعماري. ينتقد غلاب التقليد الأعمى للأيديولوجيات الأجنبية ( الليبرالية أو الماركسية )، ويدعو إلى فكر تقدمي وطني أصيل. ويرى غلاب أن هذا الفكر يجب أن يُوفق بين الإيمان والحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية الجماعية. ويُقدّم المقال نفسه كبيان فكري، وكرد فعل على التوترات الأيديولوجية التي سادت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في وقت كانت فيه المناقشات الإيديولوجية مكثفة في المغرب ( بين القومية والاشتراكية والإسلام السياسي )، ويؤكد على الطريق الوسطي الذي تدافع عنه حركة الاستقلال: التقدم المتجذر في التقاليد والمنفتح على الحداثة.
2. البنية والسرد
يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء رئيسية:
-
تعريف مفهوم التقدم ونقد الأيديولوجيات المستوردة؛
-
الأسس الثقافية والروحية للتقدم الإسلامي والعربي؛
-
تطبيق الفكر التقدمي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
يتنقل عبد الكريم غلاب بين التحليل النظري والأمثلة الملموسة المستمدة من الواقع المغربي.
3. الشخصية والرمزية
البطل الضمني هو "الإنسان المغربي المعاصر"، المدعو إلى التصالح مع ثقافته من أجل بناء تقدم حقيقي. ورمزية هذا التقدم ليست تقنية ولا مادية، بل أخلاقية وجماعية عميقة.
4. المواضيع الرئيسية
-
التقدم كمشروع أخلاقي واجتماعي؛
-
نقد التقليد الأيديولوجي؛
-
التفاعل بين الإيمان والحداثة والتنمية؛
-
العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية؛
-
بناء فكر وطني مستقل .
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
أسلوب الكتابة واضح، جدلي، وتعليمي. يستخدم عبد الكريم غلاب مفردات أيديولوجية دقيقة، لكنها مُعتدلة بدوافع إنسانية. يجمع أسلوبه بين صرامة الناشط وعمق المفكر.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
لاقى هذا المقال استحسانًا في الأوساط السياسية والفكرية القومية، التي رأت فيه توليفة ناجحة بين الهوية الثقافية والفكر التقدمي. كما اعتبره بعض النقاد بيانًا لـ"الإصلاحية المغربية" في مواجهة تجاوزات الفكر الماركسي والمحافظة الدينية.
خاتمة :
في كتابه "الفكر التقدمي في الأيديولوجية التقدمية"، يُعرّف عبد الكريم غلاب طريقًا ثالثًا بين المحافظة والمادية: طريق التقدم الأخلاقي والروحي والاجتماعي القائم على كرامة الإنسان. ويظل هذا النص مرجعًا أساسيًا لفهم المفهوم الاستقلالي للتنمية ورؤية عبد الكريم غلاب الأخلاقية للتقدم.
الفكر التقدمي في الأيديولوجية التعادلية
نُشر لأول مرة في عام 1979
-
مجموعة الرسالة للصحافة، الرباط
طبعات أخرى:
-
منشورات حزب الاستقلال، الرباط (1981)
-
دار الكتب، الدار البيضاء (1988، 1996)
في هذا النص، المُكمِّل لمقاله السابق "الفكر التقدمي في أيديولوجية التقدم"، يتعمق عبد الكريم غلاب في مفهوم "الأيديولوجية المساواتية" - العقيدة السياسية لحزب الاستقلال. ويُطوِّر مفهوم التوازن الديناميكي بين الأصالة والمعاصرة، والإيمان والعقل، والحرية والمسؤولية، واضعًا الإنسان في صميم المشروع الوطني.
ملخص :
يستكشف الكتاب التداعيات الفلسفية والأخلاقية والسياسية لفلسفة "التوازن/المساواة"، التي تُعتبر المسار المغربي نحو التنمية الاجتماعية والديمقراطية. يُقارن عبد الكريم غلاب بين الاختلال الأيديولوجي للنماذج المستوردة ( الليبرالية المفرطة أو الاشتراكية العقائدية ) ورؤية مجتمعية متناغمة قائمة على العدالة والشورى والتضامن. إنه بيان عقائدي وتأمل في استدامة النموذج المغربي للتطور السياسي.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا النص أواخر سبعينيات القرن الماضي، في فترة إعادة تقييم أيديولوجي في المغرب. أعاد حزب الاستقلال صياغة رؤيته السياسية في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. لذا، يُشكل عمل عبد الكريم غلاب ميثاقًا فكريًا لحركة الاستقلال، مؤكدًا دورها كقوة إصلاحية، لا ثورية.
2. البنية والسرد
يعتمد المقال على بنية جدلية: يُقارن كل قسم بين التطرف ( المادية/الروحانية، السلطة/الحرية، التقدم/التقليد ) للوصول إلى توليفة متناغمة. يستعين الكاتب بالتاريخ المغربي والفكر الإسلامي والتجارب الدولية لتوضيح مفهومه للتوازن الاجتماعي.
3. الشخصية والرمزية
الشخصية المحورية هي المواطن "المتوازن"، الذي يمثل الرجل المغربي المثالي: مثقف، متدين، حر، ومتحد. يُصبح "التوازن" استعارة للنضج السياسي والأخلاقي للبلاد.
4. المواضيع الرئيسية
-
التوازن بين التقليد والحداثة؛
-
العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني؛
-
الديمقراطية التشاورية ومشاركة المواطنين؛
-
الهوية المغربية في مواجهة العولمة الإيديولوجية؛
-
المسؤولية الأخلاقية للسلطة والمواطن
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
يعتمد عبد الكريم غلاب أسلوبًا جدليًا دقيقًا، قريبًا من اللغة العقائدية، لكنه يتخلله نفحات شعرية عند استحضاره الوطن أو العدالة. يتميز المقال بتماسكه المصطلحي القوي ودقته في العرض، المستمدة من خبرته الصحفية.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
حظي هذا العمل بإشادة واسعة في الأوساط السياسية والأكاديمية، باعتباره أحد النصوص الأساسية للفكر الاستقلالي الحديث. وقد رأى فيه الباحثون جهدًا نادرًا في التنظيم الأيديولوجي ضمن المجال السياسي العربي. كما فسّره البعض على أنه محاولة للتوفيق بين الإسلام السياسي والديمقراطية التعددية.
خاتمة :
في كتابه "الفكر التقدمي في الأيديولوجية التعادلية"، يقدم عبد الكريم غلاب صياغة نظرية للمسار الوسطي للقومية المغربية: مسار الاعتدال والتوفيق. ومن خلال التوفيق بين المقتضيات الروحية والاجتماعية للتقدم، يجعل غلاب التوازن مبدأً توجيهيًا للفكر والسياسة والحياة الجماعية.
المنظور الإستقلالي للسياسة الوطنية والاقتصادية والاجتماعية
نُشر لأول مرة في عام 1979
-
مجموعة الرسالة للصحافة، الرباط
طبعات أخرى:
-
منشورات حزب الاستقلال، الرباط (1983)
-
دار الكتب، الدار البيضاء (1990، 1998)
يُطوّر هذا المقال المنظور السياسي والأيديولوجي لحزب الاستقلال تجاه القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية. يجمع عبد الكريم غلاب بين التأمل التاريخي والمقترحات البرامجية، مُشدّدًا على أهمية اتباع نهج متوازن وتقدمي لتعزيز استقلال المغرب وتنميته.
ملخص :
يُحلل عبد الكريم غلاب الركائز الأساسية للسياسة الوطنية: سيادة الدولة، والتنمية الاقتصادية المستقلة، والعدالة الاجتماعية. ويوضح مبادئ الحكم الاستقلالي: تغليب المصلحة العامة، والتكامل الاجتماعي، والترشيد الاقتصادي، ومشاركة المواطنين. ويُمثل هذا العمل بيانًا عقائديًا يهدف إلى توجيه الإصلاح السياسي والاقتصادي للبلاد في سنوات ما بعد الاستقلال .
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ويتناول تحديات التحديث الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي في المغرب الذي يمر بمرحلة انتقالية سياسية عميقة. وهو متجذر في الفكر الوطني، الموجه نحو سيادة الدولة وفعاليتها.
2. البنية والسرد
يتألف الكتاب من ثلاثة أقسام رئيسية: السياسة الوطنية، والاقتصاد، والمجتمع. يجمع كل قسم بين التحليل التاريخي والتشخيص النقدي والتوصيات العملية، رابطًا بين النظرية والتطبيق.
3. الشخصية والرمزية
البطل الضمني هو الدولة المغربية، باعتبارها الضامن للسيادة والرفاه الجماعي. والمواطن هو المحور، المدعو لممارسة حقوقه ومسؤولياته في إطار من التضامن الوطني.
4. المواضيع الرئيسية
-
السيادة الوطنية والاستقلال السياسي؛
-
التنمية الاقتصادية والتصنيع؛
-
العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؛
-
المشاركة المدنية والمشاركة السياسية؛
-
الأخلاق والمسؤولية في الحكم.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
أسلوب الكتابة تعليمي، جدلي، ودقيق. يجمع عبد الكريم غلاب بين الدقة التحليلية والأسلوب الشيق، مُبرزًا وضوح المفاهيم والقوة الأخلاقية لمقترحاته.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
استُخدم هذا العمل مرجعًا في نقاشات السياسة الاقتصادية والاجتماعية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وقد عزز سمعة عبد الكريم غلاب كمفكر وطني ومثقف ملتزم، قادر على صياغة النظرية والممارسة السياسية.
خاتمة :
في مقاله "المنظور الإستقلالي للسياسة الوطنية والاقتصادية والاجتماعية"، يؤكد عبد الكريم غلاب على تماسك النهج الوطني القائم على التقدم المتوازن والعدالة والمسؤولية الجماعية. ويعزز هذا العمل مكانته كمرشد فكري في الخطاب الدائر حول تحديث المغرب وسيادته.
مع الشعب في البرلمان
نُشر لأول مرة في عام 1983
-
صحافة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
طبعات أخرى:
-
منشورات حزب الاستقلال، الرباط (1985)
-
دار الكتب، الدار البيضاء (2000)
يروي هذا المقال تجربة عبد الكريم غلاب البرلمانية ورؤيته للديمقراطية التمثيلية. يجمع المقال بين السيرة الذاتية والتأمل السياسي، مسلطًا الضوء على دور المسؤولين المنتخبين في الدفاع عن مصالح الشعب وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في المغرب.
ملخص :
يروي عبد الكريم غلاب تجربته في البرلمان المغربي، مُحللاً تحديات التمثيل السياسي، وعمل اللجان البرلمانية، ودور النقاش البرلماني في الحياة الوطنية. ويجادل بأن الديمقراطية لا تقتصر على الإجراءات الرسمية، بل تشمل أيضاً الإنصات والمساءلة والمشاركة الفاعلة للممثلين المنتخبين. تُعدّ هذه المقالة بمثابة سرد شخصي ودليل عملي للسياسة الوطنية الأخلاقية والفعالة.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا العمل في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ويأتي بعد عقود من الخبرة البرلمانية. يندرج هذا العمل ضمن تقاليد التأمل السياسي للمثقفين المغاربة الملتزمين، مقدمًا توليفة بين الملاحظة العملية والنظرية السياسية.
2. البنية والسرد
ينقسم الكتاب إلى فصول موضوعية تتناول: مهام البرلمان، وعلاقته بالشعب، ودور اللجان، وعلاقته بمؤسسات الدولة. ويتراوح السرد بين الحكايات الشخصية، والتحليلات المؤسسية، والتوصيات لبناء برلمان فعّال.
3. الشخصية والرمزية
البطل الضمني هو المواطن المستشار النائب، رمز المشاركة المسؤولة واليقظة الديمقراطية. يُصبح البرلمان مكانًا رمزيًا للحوار والتماسك الوطني.
4. المواضيع الرئيسية
-
المسؤولية والتمثيل البرلماني؛
-
الحوار بين المسؤولين المنتخبين والمواطنين؛
-
التطوير المؤسسي والتشريعي؛
-
الأخلاق والشفافية السياسية؛
-
دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
أسلوب الكتابة واضح، سهل الفهم، وملتزم. يمزج عبد الكريم غلاب بين الدقة التحليلية والسرد الحي، متنقلاً بين الشهادة الشخصية والتأمل السياسي. أسلوبه تعليمي ومقنع في آن واحد.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
حظي الكتاب بإشادة لوضوحه وقيمته التعليمية. ولا يزال طلاب العلوم السياسية والبرلمانيون يستعينون به كمرجع للممارسة الديمقراطية في المغرب.
خاتمة :
في مقاله "مع الشعب في البرلمان"، يُبرز عبد الكريم غلاب الترابط بين المسؤولين المنتخبين والمواطنين. ويُبرز المقال قناعته بأن الديمقراطية ممارسة يومية، قائمة على المشاركة والمسؤولية والالتزام الفكري والأخلاقي.
سلطة المؤسسات بين الشعب والحكم
دراسة دستورية سياسية
نُشر لأول مرة في عام 1987
-
صحافة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
طبعات أخرى:
-
منشورات حزب الاستقلال، الرباط (1987)
-
دار الكتب، الدار البيضاء (2001)
يتعمق هذا المقال السياسي في تحليل العلاقة بين مؤسسات الدولة والسيادة الشعبية في المغرب. ويتناول عبد الكريم غلاب الآليات الدستورية، وتوزيع السلطات، وكيف يمكن للمؤسسات أن تخدم الصالح العام مع ضمان الاستقرار السياسي.
ملخص :
من خلال تحليل دقيق للإطار الدستوري المغربي، يدرس عبد الكريم غلاب توزيع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودورها في حماية حقوق المواطنين. ويؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحكومة والشعب، والمسؤولية الأخلاقية والمدنية للمؤسسات. ويجمع الكتاب بين النظرية السياسية والتوصيات العملية لترسيخ دولة ديمقراطية مسؤولة.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في ثمانينيات القرن الماضي، في فترة إصلاحات مؤسسية ونقاشات حول الدستور، وهو يندرج ضمن منهج التحليل السياسي الجاد. ويعكس رؤية حزب الاستقلال لدولة قوية تحترم مشاركة المواطنين.
2. البنية والسرد
يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء رئيسية:
-
دراسة المؤسسات المغربية وتطورها التاريخي؛
-
تحليل العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛
-
اقتراح آليات لتعزيز الشرعية الديمقراطية.
يتناوب السرد بين الحجج القانونية والرسوم التوضيحية التاريخية.
3. الشخصية والرمزية
تصبح المؤسسات نفسها "شخصيات" رمزية، تُمثل مبادئ العدالة والمسؤولية والاستمرارية الوطنية. ويُقدم الشعب على أنه الحارس النهائي للشرعية السياسية.
4. المواضيع الرئيسية
-
الدستور وتوزيع السلطات؛
-
مسؤولية المؤسسات تجاه الشعب؛
-
الحوار بين الحاكم والمواطن؛
-
الأخلاق والشفافية في الحوكمة؛
-
تعزيز الديمقراطية البرلمانية.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
أسلوب عبد الكريم غلاب تحليلي، واضح، ودقيق، يجمع بين الدقة القانونية والعمق الأخلاقي. يبقى أسلوبه سهل الفهم رغم تعقيد المفاهيم الدستورية.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
حظي الكتاب بقبول واسع من الأكاديميين والممارسين السياسيين. ويُعتبر مرجعًا أساسيًا لفهم ديناميكية المؤسسات المغربية وضرورة التوازن بين السلطة والشعب.
خاتمة :
في مقاله "سلطة المؤسسات بين الشعب والحكم"، يقدم عبد الكريم غلاب رؤية متوازنة وواقعية للدولة المغربية. ويوضح المقال قناعته بأن احترام المؤسسات والمسؤولية المدنية هما ركيزتا ديمقراطية مستقرة ودائمة.
التطور الدستوري والنيابي في المغرب
من سنة 1908 إلى سنة 1988
نُشر لأول مرة في عام 1988
-
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
طبعات أخرى:
-
منشورات حزب الاستقلال، الرباط (1989)
-
دار الكتب، الدار البيضاء (1995، 2002)
هذه المقالة تحديثٌ وامتدادٌ للمجلد السابق (1908-1977). يُحلل عبد الكريم غلاب التغييرات الدستورية والبرلمانية التي حدثت بين عامي 1977 و1988، وهي فترةٌ اتسمت بإصلاحاتٍ سياسيةٍ هامةٍ وتوتراتٍ اجتماعية.
ملخص :
يقدم عبد الكريم غلاب الإصلاحات الدستورية والتطورات البرلمانية منذ عام 1977، مُركزًا على تكيف المؤسسات مع الواقع السياسي والاجتماعي الجديد. ويصف تطور النظام البرلماني، والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحديات تمثيل المواطنين في سياق التحديث والحفاظ على الاستقرار الوطني.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهو يعكس اهتمامات المثقفين المغاربة بالإصلاحات المؤسسية وترسيخ الديمقراطية البرلمانية. وهو يُكمّل التأمل التاريخي الذي تناوله عبد الكريم غلاب في كتابه السابق.
2. البنية والسرد
ويتبع الكتاب منهجًا زمنيًا وموضوعيًا:
-
التطورات التشريعية بعد عام 1977؛
-
الإصلاحات الدستورية وتداعياتها على الحكم؛
-
تحليل التوترات السياسية والاستجابات المؤسسية.
يجمع السرد بين الحقائق التاريخية والتعليقات النقدية والتوصيات.
3. الشخصية والرمزية
تظل المؤسسات المغربية هي الأطراف الفاعلة ضمنيًا، إذ تُجسّد استمرارية النظام السياسي وتحديثه. ويُمثّل الشعب رمزيًا كحَكَمٍ على شرعية الإصلاحات.
4. المواضيع الرئيسية
-
الإصلاحات الدستورية والبرلمانية؛
-
العلاقات بين الملكية والبرلمان؛
-
مسؤولية المؤسسات وشرعيتها؛
-
المشاركة المدنية والاستقرار السياسي؛
-
تكييف الهياكل مع الحداثة.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
أسلوب الكتابة واضح ودقيق ومنظم. يحافظ عبد الكريم غلاب على أسلوبه التحليلي، المُثري برؤى نقدية وتأملات أخلاقية حول دور المؤسسات في المجتمع.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
لاقت هذه المقالة استحسانًا واسعًا باعتبارها امتدادًا ضروريًا للمجلد السابق. وقد استُخدمت على نطاق واسع من قِبل الباحثين والعلماء القانونيين وطلاب العلوم السياسية لفهم استمرارية النظام الدستوري المغربي وتحولاته.
خاتمة :
في كتابه "التطور الدستوري والنيابي في المغرب من سنة 1908 إلى سنة 1988"، يؤكد عبد الكريم غلاب دوره كشاهد ومحلل للتاريخ المؤسسي المغربي. ويُبيّن الكتاب أن ترسيخ الديمقراطية يعتمد على الإصلاحات التدريجية والمشاركة المدنية، مُلخّصًا بذلك رؤيته لدولة متوازنة ومسؤولة.
لماذا انهارت الشيوعية
نُشر لأول مرة في عام 1991
-
دار نيو هورايزون للنشر والتوزيع، بيروت
طبعة أخرى:
-
دار الكتاب المغربي، الرباط (1998)
في هذه المقالة، يتناول عبد الكريم غلاب انهيار الشيوعية في نهاية القرن العشرين، لا سيما بتفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية. ويحلل الأسباب الكامنة وراء هذا التدهور الأيديولوجي والسياسي، ويضعه في سياق التحديات التي تواجه العالمين العربي والإسلامي.
ملخص :
يصف عبد الكريم غلاب انهيار الشيوعية ليس كحدث سياسي فحسب، بل كنهاية دورة أيديولوجية فشلت في تلبية التطلعات الإنسانية الأساسية. ويوضح كيف أن حرمان الحرية، والمركزية المفرطة للسلطة، وغياب الروحانية قوّضت أسس النظام. كما يؤكد أن فشل الشيوعية يجب أن يكون درسًا للدول العربية التي تسعى إلى طريقها الخاص نحو العدالة والتقدم.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
كُتب هذا النص في أعقاب سقوط جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفيتي، وهو يعكس اهتمام عبد الكريم غلاب بالأحداث العالمية الراهنة. ويُمثّل دخوله إلى الفكر الجيوسياسي والأيديولوجي الدولي، عند ملتقى الفلسفة السياسية والأخلاق.
2. البنية والسرد
ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
-
التحليل التاريخي للماركسية وتطبيقاتها السياسية؛
-
تشخيص الأسباب الداخلية للانهيار؛
-
تأملات مقارنة مع العالم العربي.
ويتراوح النغمة بين التحليل الوثائقي والتأمل الأخلاقي والتفكير الاستراتيجي.
3. الشخصية والرمزية
الشيوعية تُجسّد تقريبًا، وتُعتبر أيديولوجيةً ادعت إنقاذ البشرية، لكنها في النهاية دمّرت نفسها. ويُصبح " الرجل الحر " رمزًا مُقابلًا، تجسيدًا للكرامة الإنسانية والحقيقة الروحية.
4. المواضيع الرئيسية
-
فشل النموذج الماركسي اللينيني؛
-
أزمة الفكر المادي؛
-
دور الحرية والإيمان في البناء الاجتماعي؛
-
دروس للدول العربية؛
-
تأملات حول نهاية الأيديولوجيات
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
يجمع المقال بين أسلوب جدلي مكثف ونثر واضح ومختصر. يستخدم عبد الكريم غلاب استعارات قوية (النظام كعملاق ذي أقدام من طين) ويعزز تحليله بإشارات تاريخية وأخلاقية.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
حظيت المقالة بقبولٍ واسعٍ في الأوساط الفكرية العربية، وأُشيدَ بوضوحها ودقتها التحليلية. وأشار بعض النقاد إلى نهجها الأخلاقي في السياسة، الذي يقع في منطقةٍ ما بين الفلسفة الأخلاقية والملاحظة التجريبية.
خاتمة :
كتاب "لماذا انهارت الشيوعية" تأملٌ في محدودية أي أيديولوجية تدّعي احتكار الحقيقة وتجاهل البعد الروحي للإنسانية. يرى عبد الكريم غلاب أن الدرس الجوهري يكمن في ضرورة التوفيق بين الحرية والعدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية - وهو طريق وسطي يجب على المجتمعات العربية أن تبتكره لنفسها.
في الفكر السياسي
نُشر لأول مرة في عام 1992
-
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء
طبعة أخرى:
-
دار الكتاب المغربي، الدار البيضاء (1995)
يجمع هذا المقال تأملات عبد الكريم غلاب في الفكر السياسي العربي المعاصر، وأسسه، ومفارقاته، وانحرافاته. ويبحث في كيفية دمج العالم العربي - أو عدم دمجه - لمفاهيم الديمقراطية، والسيادة الشعبية، وسيادة القانون، مع سعيه في الوقت نفسه إلى الحفاظ على هويته الثقافية والدينية.
ملخص :
يتناول عبد الكريم غلاب الفكر السياسي كمجال ديناميكي مأزوم. ويعيد النظر في المراحل التاريخية للتحديث السياسي في العالم العربي، مستكشفًا الإرث الاستعماري، وصعود القومية، وتحديات الحكم بعد الاستقلال. ويدافع عن مفهوم إنساني وأخلاقي للسياسة، قائم على المسؤولية الجماعية والتوازن بين الحرية الفردية والسلطة العامة.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا العمل في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وهو يعكس فترةً من التساؤلات الأيديولوجية في العالم العربي عقب فشل القومية العربية وخيبة الأمل في الأنظمة الاستبدادية. في هذا العمل، يصوغ عبد الكريم غلاب توليفةً بين الفكر السياسي الإسلامي الكلاسيكي والحداثة الديمقراطية.
2. البنية والسرد
يتألف المقال من عدة فصول موضوعية، تتمحور حول أسئلة محورية: ما هي الشرعية السياسية؟ ما مكانة الأخلاق في السلطة؟ كيف نتجنب الاستبداد تحت ستار الحداثة؟
التنظيم واضح، مع تقدم منطقي من النظرية السياسية إلى تحليل الحالة المغربية.
3. الشخصية والرمزية
لا يتضمن النص شخصيات، لكن "المواطن العربي" يؤدي الدور الرمزي للذات الجماعية الساعية إلى الكرامة والاعتراف السياسي. وتُوصف السلطة بأنها مسؤولية واختبار أخلاقي في آن واحد.
4. المواضيع الرئيسية
-
أزمة الفكر السياسي العربي؛
-
إصلاح الحكم والدولة؛
-
دور الدين في الشرعية السياسية؛
-
الحداثة والديمقراطية والأخلاق؛
-
المشاركة والعدالة الاجتماعية.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
يتميز أسلوب عبد الكريم غلاب بدقة جدلية تُشبه الخطاب الأكاديمي، لكنه يتميز بوضوح وحيوية تُذكرنا بطبعه الصحفي. يجمع بين التفكير المنطقي وأسلوب كتابة مُلهم، بل ونبوئي أحيانًا.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
يعتبر هذا الكتاب بمثابة التوليف النهائي للفكر التاريخي المغاربي لعبد الكريم غلاب.
خاتمة :
في كتابه "في الفكر السياسي"، يُقدّم عبد الكريم غلاب توليفةً من رؤيته السياسية: رؤية مُفكّر يؤمن بالسيادة الأخلاقية للإنسانية وبضرورة دولة عادلة وديمقراطية ومسؤولة. إنه نصٌّ نقديٌّ وبنّاءٌ في آنٍ واحد، يدعو إلى إعادة تأسيس أخلاقيٍّ للسياسة العربية المعاصرة.
التطور الدستوري والنيابي في المغرب
من 1908 إلى 1992
نُشر لأول مرة في عام 1993
-
دار المؤلف، الدار البيضاء
هذه المقالة تحديثٌ وامتدادٌ للمجلد السابق (1908-1977). يُحلل عبد الكريم غلاب التغييرات الدستورية والبرلمانية التي حدثت بين عامي 1977 1992، وهي فترةٌ اتسمت بإصلاحاتٍ سياسيةٍ هامةٍ وتوتراتٍ اجتماعية.
ملخص :
يقدم عبد الكريم غلاب الإصلاحات الدستورية والتطورات البرلمانية منذ عام 1988، مُركزًا على تكيف المؤسسات مع الواقع السياسي والاجتماعي الجديد. ويصف تطور النظام البرلماني، والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتحديات تمثيل المواطنين في سياق التحديث والحفاظ على الاستقرار الوطني.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهو يعكس اهتمامات المثقفين المغاربة بالإصلاحات المؤسسية وترسيخ الديمقراطية البرلمانية. وهو يُكمّل التأمل التاريخي الذي تناوله عبد الكريم غلاب في كتابه السابق.
2. البنية والسرد
ويتبع الكتاب منهجًا زمنيًا وموضوعيًا:
-
التطورات التشريعية بعد عام 1977؛
-
الإصلاحات الدستورية وتداعياتها على الحكم؛
-
تحليل التوترات السياسية والاستجابات المؤسسية.
يجمع السرد بين الحقائق التاريخية والتعليقات النقدية والتوصيات.
3. الشخصية والرمزية
تظل المؤسسات المغربية هي الأطراف الفاعلة ضمنيًا، إذ تُجسّد استمرارية النظام السياسي وتحديثه. ويُمثّل الشعب رمزيًا كحَكَمٍ على شرعية الإصلاحات.
4. المواضيع الرئيسية
-
الإصلاحات الدستورية والبرلمانية؛
-
العلاقات بين الملكية والبرلمان؛
-
مسؤولية المؤسسات وشرعيتها؛
-
المشاركة المدنية والاستقرار السياسي؛
-
تكييف الهياكل مع الحداثة.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
أسلوب الكتابة واضح ودقيق ومنظم. يحافظ عبد الكريم غلاب على أسلوبه التحليلي، المُثري برؤى نقدية وتأملات أخلاقية حول دور المؤسسات في المجتمع.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
لاقت هذه المقالة استحسانًا واسعًا باعتبارها امتدادًا ضروريًا للمجلد السابق. وقد استُخدمت على نطاق واسع من قِبل الباحثين والعلماء القانونيين وطلاب العلوم السياسية لفهم استمرارية النظام الدستوري المغربي وتحولاته.
خاتمة :
في كتابه "التطور الدستوري والنيابي في المغرب: من 1908 إلى 1992"، يؤكد عبد الكريم غلاب دوره كشاهد ومحلل للتاريخ المؤسسي المغربي. ويُبيّن الكتاب أن ترسيخ الديمقراطية يعتمد على الإصلاحات التدريجية والمشاركة المدنية، مُلخّصًا بذلك رؤيته لدولة متوازنة ومسؤولة.
تجديد الدولة وتغيير السياسة
نُشر لأول مرة في عام 1999
-
مجموعة الرسالة للصحافة، الرباط
طبعة أخرى:
-
دار الكتاب المغربي، الدار البيضاء (2000)
في هذه المقالة، يواصل عبد الكريم غلاب تأملاته في التحول السياسي والمؤسسي في المغرب المعاصر. ويُقدّم نقدًا للممارسات السياسية الموروثة من الماضي، ويدعو إلى تجديد جذري للدولة من خلال إصلاح هياكلها وعقلياتها وثقافة الحوكمة فيها.
ملخص :
يُسلّط عبد الكريم غلاب الضوء على ضرورة إحداث تغيير منهجي، حيث لا يقتصر إصلاح الدولة على الدستور أو المؤسسات الرسمية، بل يجب أن يصاحبه تحول في الوعي السياسي الوطني. ويُشدّد على دور المواطن، والتربية المدنية، وأخلاقية الحياة العامة، كشروط أساسية للتقدم.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في مطلع القرن الحادي والعشرين، وهو يتناول فترة الإصلاحات المؤسسية المغربية التي نُفذت في عهد الحسن الثاني، ثم عززها محمد السادس. ويُظهر عبد الكريم غلاب مراقبًا ناقدًا وشاهدًا مُنخرطًا في عملية الانتقال السياسي.
2. البنية والسرد
يعتمد الكتاب على بنية تحليلية مكونة من فصول موضوعية: تشخيص النظام السياسي، تقييم المؤسسات، مقترحات الإصلاح، وأخيرا الدعوة إلى "عقد أخلاقي جديد" بين الدولة والشعب.
3. الشخصية والرمزية
لا يُقدّم النص شخصياتٍ فردية، بل جدليةً بين كيانين رمزيين: الدولة (كهيكل إداري وأخلاقي) والمجتمع (كوعي جماعي). ويُصبح حوارهما - المتصارع أحيانًا - القوة الدافعة للتجديد السياسي.
4. المواضيع الرئيسية
-
إصلاح الدولة وتحديث المؤسسات؛
-
الأخلاقيات العامة والحوكمة الأخلاقية؛
-
المشاركة المدنية والمسؤولية السياسية؛
-
العلاقة بين السلطة والخدمة العامة؛
-
الحاجة إلى ثقافة سياسية جديدة.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
يتبنى عبد الكريم غلاب لهجة تحليلية وتحريضية في آن واحد. يجمع كتابه بين دقة المفكر السياسي وحماسة الإصلاح. وتعزز الاستعارات العضوية ( الدولة ككيان حيّ في حاجة إلى التجديد ) البعدَ الديناميكي والأخلاقي لحجته.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
حظيت المقالة بقبولٍ واسعٍ في الأوساط الفكرية والسياسية، لا سيما لمنهجها المتوازن الذي جمع بين نقد القصور والثقة في قدرة المغرب على الإصلاح. وقد استُشهد بها مرارًا في نقاشاتٍ حول تحديث الإدارة وإصلاح الحوكمة العامة.
خاتمة :
يُقدّم كتاب "تجديد الدولة وتغيير السياسة" نفسه كبيانٍ لتجديد سياسي مؤسسي وأخلاقي. يقترح عبد الكريم غلاب رؤيةً تقدميةً قائمةً على الثقة بالعقل والمسؤولية والمواطنة الفاعلة. ويؤكد المقال دوره كمفكر إصلاحي ومثقف وطني يسعى نحو دولة حديثة متجذّرة في قيمها.
مائة سنة من النضال الديمقراطي
التطور الدستوري والنيابي في المغرب 1908-2011
طبعة فريدة من نوعها:
-
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء (2012)
يُمثل هذا العمل الضخم خلاصة أبحاث عبد الكريم غلاب في التاريخ السياسي والمؤسسي للمغرب. ويتتبع، على مدى قرن من الزمان، تطور النظام الدستوري والتمثيلي المغربي، من الإصلاحات الإدارية الأولى في أوائل القرن العشرين إلى دستور عام ٢٠١١، رمزًا لمنعطف ديمقراطي.
كان من الممكن أن تستمر سبع سنوات أو سبعة أشهر. لولا هذا القرار، الذي اتُخذ ضد إرادة الشعب المغربي.
يومَ زُرعتْ بذرةُ الديمقراطيةِ الأولى، كان ينبغي أن تُكملَ الديمقراطيةُ مرحلةَ تقييمِها التي دامت مئاتِ السنين في تاريخِ السلطة. جاءَ الاستعمارُ وقصفَ النبتة، وبدأ التاريخُ من عامِها الأول.
استأنف الشعب عمله بعد الاستقلال بكفاحٍ عنيد. وهو يعلم أن صفحة جديدة من التاريخ لا تُكتب إلا بكفاح. بُنيت الديمقراطيات في عواصم أوروبا، واحتضنها الشعب دون مرارة.
قال المغاربة : لا...
فلنبنِ الديمقراطية بكفاحنا. فلنبنِها بالحجر والطوب. ولنصنع المستقبل الذي نصبو إليه.
إن صبرهم على تحقيق الديمقراطية لا يوازي إلا صبرهم على الديمقراطية، وصبرهم على تحقيق الاستقلال.
ينجحون – حتى لو تعثروا – فالطفل لن يمشي مستقيماً إذا لم يتعثر.
لا زلات بعد الطفولة. المغاربة ناضجون... وحكامهم كذلك.
يتناول هذا الكتاب بعناية التطور من البذرة إلى النبات للكشف عن رؤى للمستقبل.
ملخص :
يقدم عبد الكريم غلاب، من منظور تاريخي وتحليلي، مختلف مراحل البناء السياسي للمغرب الحديث. ويتناول المواثيق والدساتير والمراجعات والممارسات البرلمانية، ويربطها بتطور الحركات الوطنية ونضج الوعي السياسي. ويوضح النص كيف ترسخت الملكية الدستورية المغربية من خلال حوار متواصل بين الأصالة والمعاصرة، والاستمرارية والإصلاح.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
صدر هذا الكتاب عشية تطبيق دستور 2011، وهو بمثابة شهادة فكرية وسياسية لعبد الكريم غلاب. وهو امتداد لدراساته السابقة حول الدستورية المغربية، ويشهد على تجربة مراقب متميز عايش جميع مراحل هذه العملية.
2. البنية والسرد
ينقسم الكتاب إلى أقسام مرتبة زمنياً:
-
نشأة الإصلاحات (1908-1956)؛
-
نشأة النظام الملكي الدستوري (1962-1970)؛
-
التعديلات والتوترات السياسية (1972-1992)؛
-
النضج الديمقراطي (1996–2011).
يجمع كل قسم بين السرد التاريخي والتعليق السياسي والتحليل المؤسسي.
3. الشخصية والرمزية
هنا، يصبح "الشعب المغربي" البطل الجماعي للقصة، مدعومًا بنظام ملكي يجسد الاستمرارية الوطنية. وتظهر شخصية الملك وشخصية الناشط السياسي كقطبين متكاملين في السعي نحو الشرعية الديمقراطية.
4. المواضيع الرئيسية
-
التاريخ الدستوري للمغرب الحديث؛
-
بناء الديمقراطية ودور الملكية؛
-
التوازن بين السلطة والتمثيل؛
-
الشرعية التاريخية والتطور القانوني؛
-
مكانة المواطن في العملية السياسية.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
يتميز أسلوب عبد الكريم غلاب بالبساطة والوضوح والبحث المعمق. تجمع كتاباته بين الدقة العلمية والشغف الوطني، بأسلوب سردي وتعليمي في آن واحد. قلمه، الذي صقلته خبرته الصحفية، يجعل المفاهيم القانونية المعقدة في متناول اليد.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
أُشيد بهذا المقال باعتباره نصًا رائدًا، وحظي بإشادة واسعة في الأوساط الأكاديمية والسياسية. ويُمثل أحد أشمل المصادر للتاريخ الدستوري للمغرب. ويتجاوز نطاقه الإطار القانوني ليشمل الذاكرة الوطنية والنضال الديمقراطي.
خاتمة :
من خلال كتابه "100 سنة من النضال الديمقراطي - التطور الدستوري والنيابي في المغرب 1908-2011"، أنتج عبد الكريم غلاب عملاً ينم عن نضج فكري ومدني. يُختتم هذا المقال رمزياً قرناً من النضال من أجل مأسسة الديمقراطية المغربية، مُشيداً بالحكمة السياسية والاستمرارية الوطنية. يُجسد هذا المقال الذاكرة والتأمل والإيمان بمستقبل المغرب الديمقراطي.
محمد بوستة ... الدبلوماسي الحكيم
طبعة فريدة من نوعها:
-
طبعات وانطباعات أبي رقراق، الرباط (2017)
في هذه المقالة السيرة الذاتية والسياسية، يُشيد عبد الكريم غلاب بأحد أبرز رموز الحركة الوطنية والدبلوماسية المغربية: محمد بوستة، رفيق الكفاح والزعيم السياسي لحزب الاستقلال. يتتبع الكتاب مسيرته وفكره السياسي ودوره في تشكيل الدبلوماسية المغربية الحديثة.
ملخص :
يقدم عبد الكريم غلاب محمد بوستة كرجل دولة نموذجي، يجمع بين الوفاء لمبادئ القومية المغربية والانفتاح على تحديات العالم المعاصر. من خلال ذكرياته الشخصية وتحليلاته السياسية، يُسلّط غلاب الضوء على مساهمة بوستة في تعزيز السياسة الخارجية المغربية، والتزامه بالقانون الدولي، ورؤيته الأخلاقية للدبلوماسية. يُمثّل النص سردًا تاريخيًا وتأملًا في الفضيلة السياسية.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
صدر هذا الكتاب قبيل وفاة عبد الكريم غلاب، وهو بمثابة تكريم وتأمل في الولاء السياسي. وهو يسير على خطى أعماله التي خصّصها لذكرى الحركة الوطنية، ويوسع في الوقت نفسه حواره مع القيم الأخلاقية للسياسة.
2. البنية والسرد
يتنقل المقال بين السرد السيرة الذاتية ( مراحل حياة محمد بوستة )، والتحليل السياسي ( مساهمته في الدبلوماسية المغربية )، والتأمل الأخلاقي في معنى الخدمة العامة. يتميز ببنية سلسة، تهيمن عليها نبرة احترام ووضوح.
3. الشخصية والرمزية
يُجسّد محمد بوستة شخصية الوطني الحكيم، الرجل الذي يضع العقل والكرامة في صميم الدبلوماسية. ويُصبح رمزًا لسياسة قائمة على الأخلاق والولاء والثبات.
4. المواضيع الرئيسية
-
الدبلوماسية المغربية وأسسها الأخلاقية؛
-
الأخلاق في العمل السياسي؛
-
دور حزب الاستقلال في تحديث المغرب؛
-
استمرارية القومية المغربية؛
-
العلاقة بين الالتزام والحكمة.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
أسلوب الكتابة بسيط وواضح، مفعم بمشاعر مكبوتة. نبرة الكاتب هي نبرة شاهدٍ مُحترم، يمزج بين البلاغة الكلاسيكية ودقة المؤرخ. يحافظ نثر عبد الكريم غلاب على هيبة أنيقة، ينقل الإعجاب والوضوح النقدي في آنٍ واحد.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
حظيت هذه المقالة بإشادة واسعة في الأوساط الفكرية والسياسية، باعتبارها شهادة قيّمة عن شخصية بارزة في المشهد المغربي. فهي تُسهم في ترسيخ ذكرى محمد بوستة في الخطاب الوطني، وتُذكّرنا بدور الأخلاق في السياسة.
خاتمة :
في كتاب "محمد بوستة... الدبلوماسي الحكيم"، يُقدّم عبد الكريم غلاب أحد أعماله الأخيرة، مفعمةً بالصداقة والوفاء وبعد النظر. يتجاوز الكتاب الصورة الشخصية، ليُقدّم تأملاً في نبل الدبلوماسية، وأخلاقيات الخدمة العامة، وقيمة الاستمرارية الوطنية. يُوسّع الكتاب رؤيته لمغرب تبقى فيه السياسة فعلًا أخلاقيًا ووطنيًا.
الشخصية: شخصية المغرب نموذجا
طبعة فريدة من نوعها:
-
طبعات وانطباعات أبي رقراق، الرباط (2017)
يقدم هذا المقال تأملاً مُركّباً حول مفهوم "الهوية الوطنية" وشخصية المغرب كبنية تاريخية وثقافية وروحية. يسعى عبد الكريم غلاب إلى تحديد أسس تماسك المغرب الحديث: الوفاء لجذوره الحضارية، ووحدة تنوعه، وقدرته على التكيف مع متغيرات العالم المعاصر.
ملخص :
من خلال تحليل تاريخي وفلسفي، يدرس عبد الكريم غلاب تشكّل الهوية المغربية منذ نشأتها وحتى العصر الحديث. ويكشف عن أبعادها الثلاثة: الإسلامية ، والأمازيغية ، والعربية ، التي توحدها السلطة الملكية والرسالة الروحية للبلاد. ويرى غلاب أن الهوية المغربية نموذج للتوازن بين الأصالة والمعاصرة، والهوية والانفتاح، والوحدة والتعددية.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
نُشر هذا المقال في أواخر حياة عبد الكريم غلاب، ويمكن قراءته كخلاصة لفكره الوطني. يأتي في وقتٍ يتصاعد فيه الجدل حول الهوية الوطنية والثقافة والعولمة في المغرب. وهو يشهد على الرؤية الأخلاقية والجامعية الراسخة للأمة التي حملها عبد الكريم غلاب.
2. البنية والسرد
يتوزع الكتاب على ثلاثة أجزاء: مقدمة حول مفهوم الشخصية الجماعية، وتحليل تاريخي لأسس المغرب، وخاتمة استشرافية حول تحديات الهوية في عصر العولمة. يجمع هيكله بين سعة الاطلاع والتأمل.
3. الشخصية والرمزية
هنا، يصبح "المغرب" شخصيةً قائمة بذاتها: كيانًا حيًا، يتشكل من التاريخ والروحانية. تُصوَّر الهوية الوطنية على أنها توليفة من الروح الجماعية والأرض والذاكرة.
4. المواضيع الرئيسية
-
الهوية المغربية ومكوناتها؛
-
الوحدة في التنوع الثقافي؛
-
دور الملكية في الاستمرارية الوطنية؛
-
الحوار بين التقليد والحداثة؛
-
المقاومة الثقافية للعولمة.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
يتبنى عبد الكريم غلاب أسلوبًا تأمليًا ورصينًا، أقرب إلى الأسلوب الفلسفي. نثره إيقاعي، مشبع بالصور الرمزية: المغرب شجرة عمرها ألف عام، والثقافة عصارة، والملكية جذع يحمي. يحتفظ كتابه بالوضوح التربوي الذي يميز مقالاته.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
قُدِّر للمقالة أنها توليفة روحية ووطنية، بل وصية فكرية لعبد الكريم غلاب. وقد لاقت صدىً قويًا في الأوساط الثقافية المغربية، حيث أججت النقاش حول الهوية والذاكرة والسيادة الثقافية.
خاتمة :
بكتاب "الشخصية: شخصية المغرب نموذجًا"، يختتم عبد الكريم غلاب مسيرته ككاتب ومفكر بتأملٍ عميق في عراقة المغرب. يُجسّد هذا العمل قناعته الراسخة بأن قوة الأمة تكمن في شخصيتها، التي يصقلها الإيمان والثقافة والوفاء للتاريخ. يُقرأ هذا النص كأنشودة وحدة وأمل، مُؤكّدًا تماسك مجمل أعماله السياسية والأخلاقية.
تشكل المقالات السياسية لعبد الكريم غلاب مرجعا أساسيا لفهم نضج الفكر الوطني المغربي .
إنها تعكس تطور الالتزام: من النضال من أجل الاستقلال إلى التأمل في الديمقراطية، ومن النشاط إلى الحكمة السياسية.
ومن خلال استمراريتهما، يشكلان سجلاً فكرياً للمغرب الحديث، كتبه رجل كان في الوقت نفسه شاهداً وممثلاً وناقداً.
ويوسع عبد الكريم غلاب مفهومه الإنساني للسياسة: " السياسة ليست الاستيلاء على السلطة، بل هي خدمة الشعب، ومسؤولية أخلاقية، والسعي لتحقيق العدالة ".
من خلال توحيد الفكر والتاريخ والأخلاق ، يرفع عبد الكريم غلاب التفكير السياسي إلى مستوى الواجب الوطني والروحي ، مما يعطي لعمله بعدا دائما في الذاكرة المغربية والعربية.