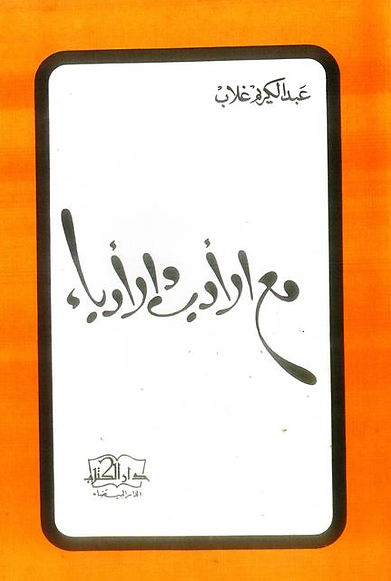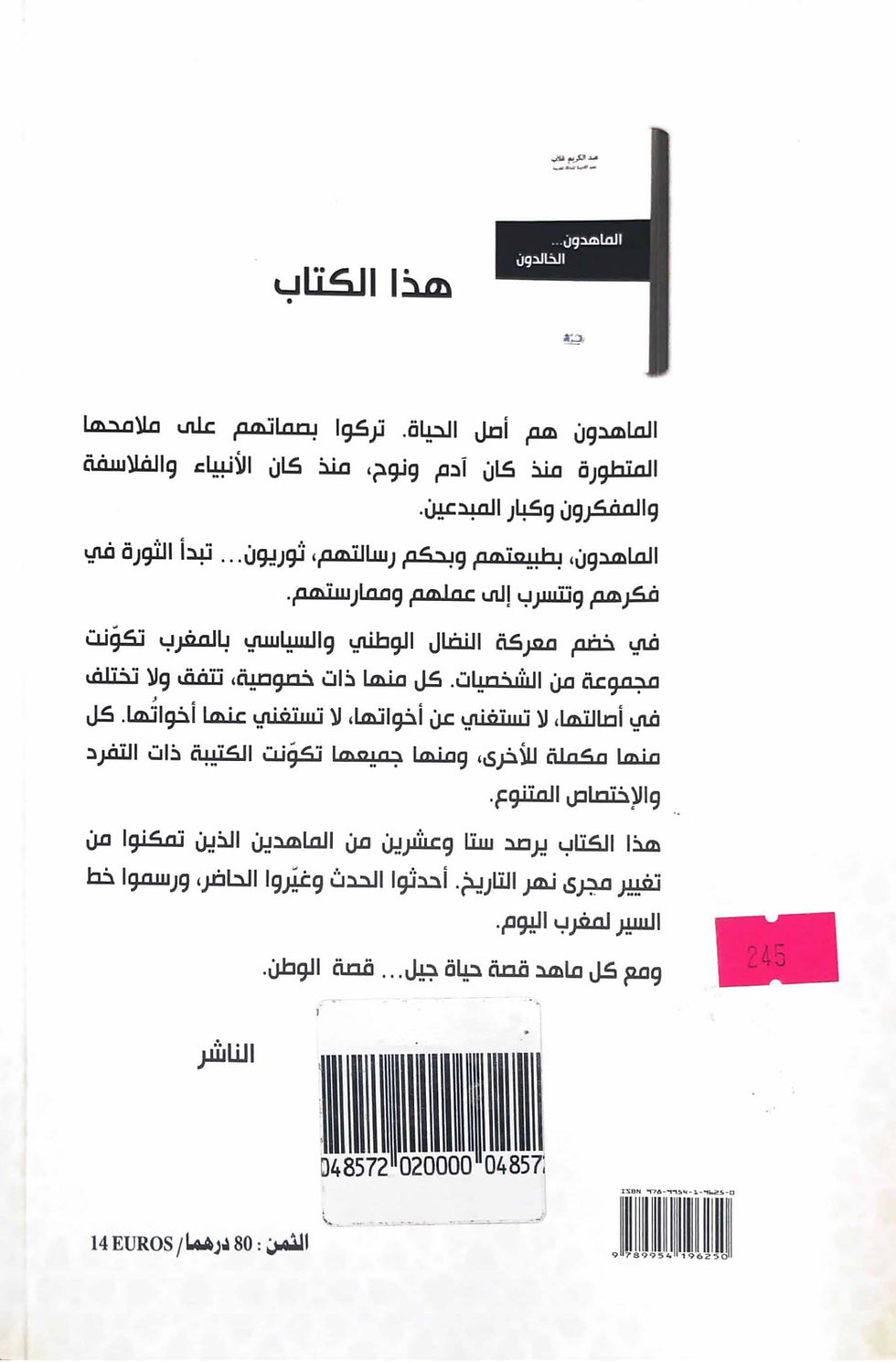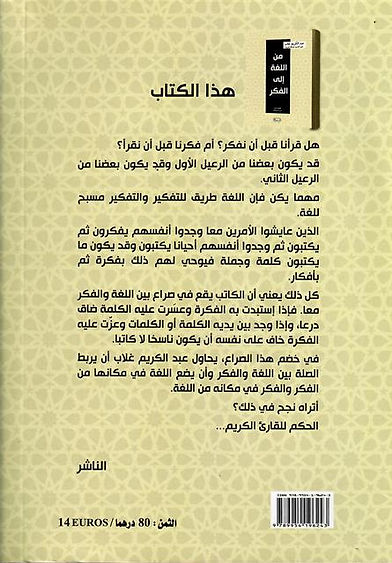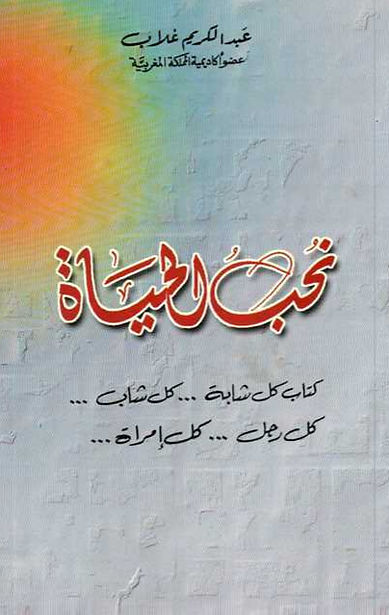1- السياق والسياق التاريخي
تتناول مقالات عبد الكريم غلاب الأدبية والفكرية مغرب ما بعد الاستقلال ، الباحث عن الهوية، وعالمًا عربيًا يمر بأزمات أيديولوجية عميقة ( القومية، الاشتراكية، الإسلام السياسي، الانفتاح الثقافي ). وتعكس هذه المقالات المسيرة الفكرية لكاتب ملتزم، يسعى إلى ربط الأدب بالفكر السياسي والتأمل الثقافي.
2- التنوع الموضوعي والوحدة الفكرية
ورغم تعدد المواضيع ـ الثقافة ( في الثقافة والأدب )، الأدب ( الدفاع عن فن الخطابة )، الفكر الإسلامي ( سمات شخصية علال الفاسي ، البعد الاجتماعي في فكر علال الفاسي )، الحداثة ( تحديات الفرنكوفونية ) ـ إلا أن ثمة وحدة تسري في كتاباته: الرغبة في التوفيق بين الأصالة الثقافية المغربية والعربية والتحديات الكونية للحداثة.
3- مكانة علال الفاسي والحركة الوطنية
يُخصِّص عبد الكريم غلاب جزءًا كبيرًا من مقالاته لعلال الفاسي، مُعلِّمه ومرجعه الفكري. ومن خلال هذه النصوص، يُشيِّد غلاب ذاكرةً فكريةً وطنيةً يتداخل فيها مفهوم التحرير مع رؤيةٍ اجتماعيةٍ وثقافية.
4 - الطريقة والأسلوب
تتبنى مقالاته نهجًا نقديًا وتربويًا وجدليًا. فهي لا تكتفي بعرض الأفكار، بل تسعى إلى الإقناع والتحفيز وتوجيه التفكير. يتأرجح أسلوبه بين الكتابة الصحفية الواضحة والكتابة الأكاديمية المنظمة، وأحيانًا الأسلوب الأدبي التأملي ( نحب الحياة ).
5 - العلاقة بين الأدب والفكر
تتقاطع العديد من مقالاته مع الأدب والتأمل الفكري. يرى عبد الكريم غلاب أن الأدب ليس منفصلاً عن العمل السياسي والاجتماعي، بل هو أداة للتربية الفكرية والأخلاقية.
6 - الاستقبال والمدى
لاقت هذه المقالات صدى واسعًا في المغرب والعالم العربي، وأصبحت مراجع أساسية في النقاشات حول:
-
الثقافة الوطنية،
-
الفرانكوفونية وتحدياتها
-
الأزمة المفاهيمية في الخطاب العربي المعاصر
-
فكر علال الفاسي.
نبضات فكر
طبعة فريدة من نوعها:
-
مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء (1961)
تعرض هذه المجموعة من المقالات والتأملات النقدية المواقف الفكرية الأولية لعبد الكريم غلاب حول الأدب والثقافة والمجتمع المغربي بعد الاستقلال. يعكس هذا العمل التزامًا ثقافيًا وسياسيًا في آنٍ واحد، يسعى إلى تحديد مكانة الفكر العربي والمغربي في العالم المعاصر.
ملخص :
يجمع الكتاب سلسلة من النصوص القصيرة التي يتناول فيها المؤلف مواضيع متنوعة: وظيفة الكاتب، ودور الثقافة في بناء الأمة، ومسألة الهوية العربية الإسلامية، وضرورة الانفتاح على الحداثة. تكشف هذه التأملات، وإن كانت مجزأة، عن تماسك فكري: قناعة راسخة بأن الفكر قوة دافعة حيوية، و"نبض" يربط الثقافة بالعمل والمجتمع.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
نُشرت هذه الرواية سنة 1961، في سياق استقلال المغرب (1956) وبناء الأمة.
-
يندرج هذا العمل ضمن تيار الفكر المغاربي الساعي إلى إعادة تعريف أسس الثقافة والهوية.
2. البنية والسرد
-
مجموعة من المقالات المستقلة، تربطها رؤية نقدية مشتركة.
-
التنظيم الموضوعي وليس الزمني، يعكس تنوع الاهتمامات.
3. الشخصية والرمزية
-
لا توجد شخصيات بالمعنى الروائي، بل هي ذات فكرية تظهر من خلال صوت الكاتب.
-
يرمز عنوان "نبضات" إلى حيوية الفكر، ويشبه نبض القلب من أجل المجتمع.
4. المواضيع الرئيسية
-
الهوية الثقافية العربية الإسلامية والأصالة.
-
الحداثة وضرورة التجديد الفكري
-
دور الأدب والكاتب في المجتمع.
-
التربية والثقافة كأساس للتحرر الوطني
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
كتابة واضحة وسهلة الفهم وخطابية في بعض الأحيان.
-
مزيج من التفكير التحليلي والنبرة النضالية.
-
استخدام الاستعارات العضوية (النبض، التنفس، الحيوية).
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
يعتبر أحد أهم المعالم الأولى في الفكر الفكري لعبد الكريم غلاب.
-
قرأها أجيال من الناشطين والأكاديميين باعتبارها شهادة على الثورة الثقافية في " فترة ما بعد الاستقلال ".
-
وتكمن قيمته اليوم في طابعه التأسيسي والوثائقي فيما يتعلق بمناقشات الستينيات.
خاتمة :
"نبضات فكر" عملٌ رائدٌ يعكس همومَ مثقفٍ يبحث عن إرشادٍ لمجتمعه حديث الاستقلال. بدمجه التأملَ الثقافيَّ والانخراطَ السياسيَّ والرؤيةَ النقدية، يُرسي عبد الكريم غلاب منهجًا: التفكيرُ من أجلِ الفعل. ويظلُّ هذا المقالُ مرجعًا أساسيًا لفهمِ الأسسِ الأوليةِ لفكرهِ وعلاقتِهِ العضويةِ بين الثقافةِ والمجتمع.
في الثقافة والأدب
نُشر لأول مرة في عام 1960
-
دار النشر المغربية، الدار البيضاء
طبعات أخرى:
-
دار أطلس للنشر، الدار البيضاء (1964)
-
جماعة الرسالة الصحفية، الرباط (1981)
يجمع هذا المقال مجموعة من المقالات والمحاضرات التي يواصل فيها عبد الكريم غلاب تأملاته حول العلاقة بين الثقافة والأدب في المجتمع المغربي. ويتناول وظيفة الكاتب، والترابط بين الأصالة والمعاصرة، ودور الثقافة كوسيلة للتحرر.
ملخص :
من خلال هذه المجموعة، يُقدّم عبد الكريم غلاب رؤيته لثقافة مُنخرطة، مُتجذّرة في التراث العربي الإسلامي، ومنفتحة على الإسهامات العالمية. ويُشدّد على ضرورة ربط الإبداع الأدبي برسالة اجتماعية وتربوية. فالأدب، بالنسبة له، ليس مُجرّد تسلية جمالية، بل أداةٌ لرفع مستوى الوعي وتعزيز التقدم الجماعي.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
صدرت في أوائل ستينيات القرن العشرين، وهي فترة بناء المؤسسات الثقافية المغربية " ما بعد الاستقلال ".
-
ويعد هذا العمل جزءًا من النقاش الفكري حول دور الأدب في الدول العربية التي خرجت حديثًا من الاستعمار.
2. البنية والسرد
-
مجموعة مهيكلة حسب المواضيع: الثقافة الوطنية، النقد الأدبي، دور الكاتب، آفاق المستقبل.
-
منظمة تعليمية تتوافق مع الخطاب الأكاديمي.
3. الشخصية والرمزية
-
تسيطر شخصية المثقف الملتزم، الذي يجسده المؤلف نفسه.
-
يتم تصوير الثقافة باعتبارها "النور" الذي ينير المجتمع، في حين يُنظر إلى الأدب باعتباره "لغته الحية".
4. المواضيع الرئيسية
-
الثقافة كركيزة من ركائز السيادة الوطنية.
-
الأدب كأداة للتربية والنقد الاجتماعي.
-
العلاقة الجدلية بين التقليد والحداثة.
-
دور الهوية العربية والهوية الإسلامية في البناء الثقافي.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
أسلوب جدلي، لكنه يتميز بالصور والاستعارات.
-
لغة واضحة وسهلة الوصول تهدف إلى إقناع جمهور واسع.
-
نبرة تحليلية وتحريضية في نفس الوقت.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
وقد تم تلقيه باعتباره مساهمة كبيرة في المناقشة حول التنمية الثقافية الوطنية.
-
وقد شكلت مرجعا في الأوساط الأكاديمية المغربية والعربية لتحليل العلاقة بين الأدب والالتزام.
-
وتكمن أهميتها الحالية في قيمتها التاريخية: فهي تعكس التوترات والتطلعات الفكرية للمغرب في ستينيات القرن العشرين.
خاتمة :
يُمثل كتاب "في الثقافة والأدب" محطةً محوريةً في فكر عبد الكريم غلاب النقدي. يُرسي هذا العمل برنامجًا فكريًا: جعل الثقافة والأدب قاطرتين أساسيتين لمجتمع يسعى نحو التحرر والحداثة. يُجسّد هذا النص ببراعة قناعة عبد الكريم غلاب بأن الكتابة جزءٌ لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية والوطنية.
رسالة فكر
نُشر لأول مرة في عام 1967
-
دار المعرفة للنشر، الرباط
طبعة أخرى:
-
دار النشر التونسية، تونس، تونس (1968)
يُقدّم كتاب "رسالة فكر" نفسه كبيان فكري يُقدّم فيه عبد الكريم غلاب رؤيته للفكر العربي المعاصر بإيجاز وقوة. وهو أكثر من مجرد مجموعة مقالات، بل هو محاولة لرسم مسار واضح للفكر الثقافي والاجتماعي في المغرب والعالم العربي.
ملخص :
في هذه المقالة، يُشدد عبد الكريم غلاب على مهمة المثقف كحامل رسائل، ومن هنا جاء عنوانها: الفكر ليس تخمينًا مُجرّدًا، بل مسؤولية جماعية. ويُشدد على ضرورة التوفيق بين الأصالة والحداثة، وإصلاح الفكر الديني، وتعزيز ثقافة نقدية قادرة على مواجهة تحديات عصرنا (الاستعمار، والتخلف، وأزمة الهوية).
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
صدر هذا الكتاب في عام 1967، وهو العام الذي شهد النكسة ( حرب الأيام الستة )، والتي أثارت أزمة كبرى في الفكر العربي.
-
تساهم المقالة في النقاشات الفكرية المكثفة التي أعقبت الهزيمة العربية، بين التساؤل والرغبة في التجديد.
2. البنية والسرد
-
مُنظمة في فصول قصيرة، على غرار البيان.
-
السرد الحجاجي، المبني على المسلمات والمبادئ.
3. الشخصية والرمزية
-
"الفكر" يتجسد في صورة رسول وحامل للحقيقة والمسؤولية.
-
ويُقدَّم المثقف باعتباره مرشدًا أخلاقيًا وسياسيًا لمجتمعه.
4. المواضيع الرئيسية
-
مسؤولية المثقف تجاه التاريخ
-
الحاجة إلى التفكير النقدي والإصلاحي.
-
أزمة الهوية والبحث عن الأصالة
-
العلاقة بين الفكر العربي والعالمية.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
أسلوب واضح وخطابي، ويقترب في بعض الأحيان من الوعظ.
-
نبرة تحليلية وتحريضية في نفس الوقت.
-
استخدام عبارات لافتة للنظر تهدف إلى تذكرها كشعارات فكرية.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
حظي الكتاب في الأوساط الفكرية المغربية والعربية بقبول واسع باعتباره نصا للتعبئة والتأمل.
-
إن أبعادها التي تشبه البيان الصحفي جعلتها مرجعًا في النقاش حول المشاركة الفكرية.
-
ولا يزال الكتاب يشكل اليوم وثيقة مهمة لفهم حالة الفكر العربي بعد عام 1967.
خاتمة :
"رسالة فكر" نداء فكري يُجسّد هموم عبد الكريم غلاب في خضمّ الاضطرابات السياسية والثقافية التي يشهدها العالم العربي. بمنحه الفكرَ دورَ رسالةٍ موجهةٍ للمجتمع، يُؤكّد غلاب قناعةً راسخةً: أن التفكيرَ فعل. وتُبرز هذه المقالة رغبته في الربط الوثيق بين الثقافة والالتزام والمسؤولية التاريخية.
دفاع عن فن القول
نُشر لأول مرة في عام 1968
-
دار الثقافة، الرباط
طبعة أخرى:
-
دار الكتاب العربي، تونس / طرابلس (1972)
تُركز هذه المقالة على قيمة الخطاب والأسلوب الأدبي في التراثين العربي والحديث. يتناول عبد الكريم غلاب البلاغة والسرد والنقد، مُؤكدًا أن "الحديث" لا يقتصر على النقل فحسب، بل يشمل أيضًا الإبداع والإقناع والتثقيف.
ملخص :
في هذه المقالة، يُحلل عبد الكريم غلاب دور اللغة والخطابة في التطور الثقافي العربي. ويدعو إلى استمرارية بين التراث الكلاسيكي للبلاغة العربية (الأدب) ومتطلبات الأدب المعاصر. ويؤكد المقال أن فن الخطابة ركن أساسي في نقل الأفكار والحوار الثقافي وبناء هوية فكرية نابضة بالحياة.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
نُشر هذا الكتاب في أواخر ستينيات القرن العشرين، وهي فترة شهدت تأملاً مكثفاً حول دور الأدب الوطني.
-
وهو جزء من حركة عربية قومية تثمن التراث البلاغي وتحديث أشكال التعبير.
2. البنية والسرد
-
ينقسم الكتاب إلى مقالات قصيرة، كل فصل يتناول جانبًا من جوانب فن التحدث: البلاغة، والسرد، والنقد، والأسلوب.
-
رواية تحليلية، لكنها مملوءة بالإشارات التاريخية والأدبية.
3. الشخصية والرمزية
-
وينظر إلى " القول " باعتباره كائناً حياً، يتمتع بوظيفة اجتماعية وثقافية.
-
ويبدو أن الكتاب والشعراء والخطباء هم حراس هذا التقليد.
4. المواضيع الرئيسية
-
أهمية البلاغة العربية الفصحى.
-
الاستمرارية بين التقليد والحداثة.
-
الكلام كأداة للتعليم والمشاركة
-
نقد التقليل من شأن الخطابة لصالح الخطاب التقني.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
أسلوب مصقول، وتوضيحي، مع إشارات علمية.
-
التناوب بين التحليل النظري والمقاطع ذات النبرة السامية.
-
إيقاع خطابي يذكرنا أحيانًا بأسلوب الخطباء.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
حظي الكتاب بقبول واسع في الأوساط الأدبية المغربية، لاسيما باعتباره مساهمة في النقد البلاغي الحديث.
-
وقد ورد ذكرها في العديد من الدراسات حول الأدب العربي المعاصر كمحاولة لإعادة تأهيل فن الخطابة.
-
عمل تكويني للعديد من طلاب الأدب في السبعينيات والثمانينيات.
خاتمة :
"دفاع عن فن القول" دفاعٌ شغوفٌ عن الخطابة كأداة ثقافية وجمالية. يؤكد عبد الكريم غلاب على أهمية الحفاظ على ثراء الخطاب العربي وإحيائه، مع تكييفه مع متطلبات الحداثة. يعكس هذا النص قناعته بأن الأدب ليس مجرد كتابة، بل هو أيضًا فن الكلام، وفن الإقناع، وفن النقل.
مع الأدب والأدباء
نُشر لأول مرة في عام 1974
-
دار الكتب، الدار البيضاء
طبعة أخرى:
-
دار النشر، الدار البيضاء (1979)
يجمع هذا المقال مجموعة من النصوص النقدية والتأملية حول الكُتّاب العرب والمغاربة، بالإضافة إلى القضايا الجمالية في الأدب الحديث. يعرض عبد الكريم غلاب قراءاته وتقييماته ونقاشاته مع هذه الأعمال، مُبرزًا بذلك دوره كناقد ووسيط وشاهد على الحياة الأدبية المعاصرة.
ملخص :
في هذا المقال، يتبنى عبد الكريم غلاب موقف القارئ المتفاعل، مستكشفًا أعمال الكُتّاب المغاربة والعرب الذين يُعجب بهم أو ينتقدهم أو يُسائلهم. يتنقل الكتاب بين تحليل أعمال مُحددة، وصورٍ للمؤلفين، وتأملاتٍ عامة حول تطور الأدب. يُمثل الكتاب سجلًا قيّمًا للمشهد الأدبي المغربي في سبعينيات القرن الماضي، وبيانًا لالتزام عبد الكريم غلاب بالأدب كمرآةٍ لمجتمعٍ مُتغير.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
صدر في وقت كان فيه الأدب المغربي لا يزال يبحث عن قواعده وهويته.
-
يعكس الدور الفعال لعبد الكريم غلاب في تأسيس حقل نقدي حديث في المغرب.
2. البنية والسرد
-
يتألف من فصول مستقلة، يركز كل منها على مؤلف أو موضوع أدبي.
-
بنية مرنة، مثل دفتر ناقد أدبي.
3. الشخصية والرمزية
-
ويبدو الكتاب بمثابة شخصيات وسيطة بين المجتمع ومستقبله.
-
ويُرمز إلى الأدب باعتباره مساحة للحوار والانفتاح والإبداع.
4. المواضيع الرئيسية
-
دراسة لمسارات الأدباء العرب والمغاربة.
-
تأملات حول تطور الرواية والشعر العربيين.
-
نقد نقائص المجال الثقافي المحلي.
-
التأكيد على مركزية الكاتب في التقدم الاجتماعي.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
أسلوب تعليمي نقدي وسهل الوصول إليه.
-
مزيج من الاقتباسات والتحليلات والتعليقات الشخصية.
-
يتميز عبد الكريم غلاب بالأناقة الكلاسيكية للنثر.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
وقد تم استعماله كمرجع في الجامعات المغربية والعربية لدراسة النقد الأدبي المعاصر.
-
اعتبرت هذه المبادرة محاولة لتأريخ الذاكرة النقدية ودعم الكتاب المغاربة الناشئين.
-
ويعتبر إنجازا بارزا في تشكيل الخطاب النقدي الوطني.
خاتمة :
يُبرز المقال "مع الأدب والأدباء" دور عبد الكريم غلاب كوسيط وكاتب وناقد ومؤرخ أدبي. وبمُشاركته الأدب ومؤلفيه، يُظهر غلاب تعلقًا عميقًا بالعمل الأدبي، الذي يُنظر إليه كوسيط بين الفرد والجماعة، وبين الماضي والمستقبل. ويحتفظ هذا العمل بقيمة توثيقية ونقدية بالغة الأهمية حتى اليوم.
ملامح من شخصية علال الفاسي
طبعة فريدة من نوعها:
-
مجموعة أريسالا للصحافة، (1974)
هذه المقالة بمثابة تكريم فكري وسيري من عبد الكريم غلاب لعلال الفاسي، شخصية رمزية في الحركة الوطنية المغربية، مفكرًا وسياسيًا وكاتبًا. يحاول العمل التقاط تعقيد شخصيته وأعماله ودوره في تاريخ المغرب الحديث من خلال قراءة شخصية وتحليلية في آن واحد.
ملخص :
في هذا العمل، يرسم عبد الكريم غلاب صورةً دقيقةً لعلال الفاسي، مستكشفًا تطوره الفكري، والتزامه الوطني، ودوره السياسي، وفكره الإصلاحي. يتجاوز المقال مجرد سيرة ذاتية، متعمقًا في الأبعاد الأيديولوجية والروحية لإرثه. يؤكد المؤلف على الترابط بين الرجل والمثقف والناشط، مما يجعله شخصيةً محوريةً في المغرب في القرن العشرين.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
صدرت بعد وفاة علال الفاسي (1974)، في جو من الحداد الوطني.
-
شهادة من زميل مقاتل ومثقف من نفس الجيل.
-
يساهم هذا العمل في تعزيز صورة علال الفاسي باعتباره الأب الروحي للأمة.
2. البنية والسرد
-
مُنظمة في فصول موضوعية: الحياة الشخصية، والمشاركة السياسية، والعمل الفكري.
-
رواية هجينة تجمع بين الذاكرة الشخصية والتحليل السياسي والنقد الأدبي.
3. الشخصية والرمزية
-
ويعتبر علال الفاسي شخصية بارزة في الفكر الإصلاحي والقومي المغربي.
-
وهو يرمز إلى العلاقة بين التقاليد الدينية والحداثة السياسية.
-
شخصيته مبنية على نموذج أخلاقي وفكري.
4. المواضيع الرئيسية
-
دور القادة الفكريين في النضال من أجل الاستقلال.
-
الفكر الإصلاحي الإسلامي وتكيفه مع السياق المغربي.
-
الترابط بين الالتزام الفكري والعمل السياسي.
-
الذاكرة الوطنية ونقل المثل العليا
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
أسلوب رصين ومحترم، مشبع بالإعجاب.
-
مزيج من العناصر السيرة الذاتية، والتحليلات الأيديولوجية، والذكريات الشخصية.
-
لغة واضحة وسهلة الوصول إليها، وموجهة لجمهور واسع.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
يعتبر مرجعا أساسيا في الدراسات حول علال الفاسي.
-
يستخدم في الأوساط الأكاديمية والسياسية والناشطة كمصدر وثائقي وشهادة مباشرة.
-
وهو ما يعزز الشرعية الفكرية والسياسية لعبد الكريم غلاب باعتباره حارساً للذاكرة الوطنية.
خاتمة :
في كتابه "ملامح من شخصية علال الفاسي"، يقدم عبد الكريم غلاب نصًا يُجسّد تكريمًا وتحليلًا وشهادةً في آنٍ واحد، مساهمًا في ترسيخ علال الفاسي كشخصيةٍ مؤسِّسةٍ للهوية الوطنية المغربية. يُشكّل هذا الكتاب نقطة التقاء بين السيرة الذاتية والنقد الفكري والمذكرات، ويحتفظ بقيمة تاريخية وأيديولوجية رفيعة المستوى.
الثقافة والفكر
طبعة فريدة من نوعها:
-
دار الثقافة، الدار البيضاء (1975)
يجمع هذا المقال سلسلة من تأملات عبد الكريم غلاب حول العلاقة بين الثقافة والفكر في السياقين العربي والمغربي. ويتناول ديناميكيات الإنتاج الأدبي والأيديولوجي والاجتماعي، مسلطًا الضوء على دور الثقافة كمحرك للوعي الوطني والتنمية.
ملخص :
يُصرّ عبد الكريم غلاب على أن الثقافة ليست مجرد زينة فكرية، بل هي سلاح أيديولوجي وقوة اجتماعية. ويُحلل الفكر العربي الحديث، ومواجهته للتراث الكلاسيكي، وتحديات الحداثة الغربية. ويُقدّم الكتاب نفسه كمحاولة لوضع الثقافة المغربية والعربية في سياق الحداثة، دون التخلي عن هويتها الجوهرية.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
نُشر هذا الكتاب في سبعينيات القرن العشرين، وهي فترة شهدت نقاشاً مكثفاً حول الهوية الثقافية العربية في أعقاب الهزائم السياسية والعسكرية.
-
يعكس رغبة عبد الكريم غلاب في المساهمة في النقاش الفكري العربي والمغربي.
-
جزء من حركة أوسع لإعادة تقييم القيم الثقافية ودور المثقفين.
2. البنية والسرد
-
تم تنظيم الكتاب في فصول موضوعية، تجمع بين التحليل النقدي والتأمل العام.
-
الكتابة التعليمية، أشبه بالمقال الفلسفي والاجتماعي.
3. الشخصية والرمزية
-
وتظهر الثقافة كفاعل جماعي، يساهم في تشكيل وعي الشعوب ومسارها.
-
ومن جانبهم، يرمز المثقفون إلى الوسطاء بين التراث والحداثة.
4. المواضيع الرئيسية
-
العلاقة بين التقليد والحداثة.
-
دور الثقافة في بناء الدولة والمجتمع
-
مسؤولية المثقفين والكتاب
-
الحوار بين الفكر العربي والفكر الغربي.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
نثر كثيف وتحليلي، ولكن في متناول القارئ المتعلم.
-
الاستخدام المتكرر للمراجع التاريخية والاقتباسات الأدبية.
-
لغة سياسية وفلسفية.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
وقد لاقى هذا الكتاب استحسان الأوساط الفكرية المغربية باعتباره محاولة لتنظيم رؤية ثقافية وطنية.
-
يستخدم في التدريس الجامعي كداعم لدراسة الفكر العربي المعاصر.
-
ويظل نطاقها أكاديميا ونشطا في المقام الأول.
ملخص :
يقدم كتاب "الثقافة والفكر" توليفة فكرية، يسعى فيها عبد الكريم غلاب إلى وضع الثقافة العربية والمغربية في سياق جدليات الحداثة. ومن خلال ربطه بين الثقافة والفكر، يؤكد غلاب على دورهما المحوري في النهضة الوطنية وبناء الهوية في مواجهة التحديات السياسية والحضارية.
الفكر العربي بين الاستلاب وتأكيد الذات
طبعة فريدة من نوعها:
-
دار الكتاب العربي، تونس / طرابلس (1977)
هذه المقالة من أهمّ الأعمال الفكرية لعبد الكريم غلاب. وهي تأمل نقدي في أزمة الفكر العربي الحديث، بين آثار الاغتراب الثقافي والسياسي الموروث عن الاستعمار، والسعي إلى تأكيد الهوية بشكل مستقل.
ملخص :
يُحلل عبد الكريم غلاب المعضلة الأساسية التي يواجهها الفكر العربي المعاصر: إغراء الاندماج في الحداثة الغربية من جهة، وضرورة الاستفادة من التراث الثقافي والديني من جهة أخرى . ويدعو إلى توليفة إبداعية، يتجاوز فيها الفكر العربي مجرد ردود الفعل الدفاعية ليدخل في ديناميكية التجديد وتأكيد الذات.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
نُشر هذا الكتاب بعد فترة وجيزة من الهزيمة العربية عام 1967، وهي لحظة محورية في أزمة الهوية والأيديولوجية.
-
وهو جزء من المناقشات حول القومية العربية والإسلام السياسي والحداثة.
-
ويشهد على دور عبد الكريم غلاب كمثقف منخرط في الفكر النقدي العربي.
2. البنية والسرد
-
التنظيم الحجاجي في قسمين رئيسيين:
-
تحليل أسباب الاغتراب (الاستعمار، التبعية الثقافية، الانقسامات الداخلية).
-
مسارات مقترحة لتأكيد الذات (الهوية، الثقافة، الديمقراطية، التنمية).
-
أسلوب تعليمي مبني على المنطق الجدلي.
3. الشخصية والرمزية
-
يتجسد الفكر العربي في صورة كائن مأزوم، يتأرجح بين الخسارة وإعادة البناء.
-
يمثل الاغتراب الاستبعاد التاريخي، في حين يرمز التأكيد على الذات إلى الولادة الجديدة المرجوة.
4. المواضيع الرئيسية
-
العلاقة بين الاستعمار والاغتراب الثقافي.
-
الهوية العربية والإسلامية في مواجهة النماذج الغربية.
-
- الحاجة إلى مشروع ثقافي وفكري متميز.
-
نقد التقليد الفكري والدعوة إلى الإبداع
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
أسلوب كثيف، تحليلي، ومثير للجدل في بعض الأحيان.
-
مزيج من التأمل الفلسفي والمراجع التاريخية.
-
خطابك الملتزم، الذي يتميز بالخطاب القومي والإصلاحي.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
وقد نوقش هذا العمل على نطاق واسع في الأوساط الأكاديمية العربية.
-
وقد تم استقباله باعتباره مساهمة أساسية في المناقشات حول الحداثة العربية.
-
وقد كان له تأثيره في دراسات الهوية والفكر النقدي ما بعد الاستعماري.
ملخص :
يُعد كتاب "الفكر العربي بين الاستلاب وتأكيد الذات" عملاً محورياً في الفكر الفكري لعبد الكريم غلاب. فمن خلال إرساء جدلية الاغتراب وإثبات الذات، يُقدم غلاب إطاراً تحليلياً راسخاً لفهم تحديات الفكر العربي الحديث. ويحتفظ هذا النص بأهميته الخالدة في نقاشات الثقافة والهوية والحداثة.
عالم شاعر الحمراء
نُشر لأول مرة في عام 1978
-
دار الكتب، الرباط
طبعة أخرى:
-
دار الثقافة، الدار البيضاء (1981)
هذه المقالة دراسة أدبية وتاريخية مُخصصة لابن الخطيب (1313-1374)، الشاعر والفيلسوف والسياسي الأندلسي الكبير، المعروف بـ"شاعر الحمراء". يستكشف عبد الكريم غلاب شعره وفكره ودوره في المجتمع الأندلسي، مُؤكدًا على الصلة بين الفن والسياسة والثقافة.
ملخص :
في كتابه "عالم شاعر الحمراء"، يغوص عبد الكريم غلاب في عالم الشعر الأندلسي، متخذًا ابن الخطيب مثالًا يُحتذى به. يُحلل الكتاب شعره، وفلسفته الحياتية، وكتاباته السياسية، مُسلّطًا الضوء على ثراء الحضارة الأندلسية وهشاشتها في خضمّ أفولها. يُسلّط غلاب الضوء على عالمية رسالة ابن الخطيب وأهميتها في الفكر العربي الحديث.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
صدر هذا الكتاب في سبعينيات القرن العشرين، وهي الفترة التي شهدت فيها التراث الأندلسي انتعاشاً في العالم العربي.
-
ويأتي هذا في إطار محاولة إعادة تأهيل الذاكرة الثقافية العربية الأندلسية كمصدر للإلهام الحديث.
2. البنية والسرد
-
يجمع العمل بين الدراسة السيرة الذاتية، والتحليل النصي، والتأمل النقدي.
-
سرد سلس يتناوب بين الصرامة الأكاديمية والنثر المثير.
3. الشخصية والرمزية
-
ويظهر ابن الخطيب كشخصية مثقف وشاعر ومفكر وسياسي متكامل.
-
وهو يرمز إلى عظمة الأندلس وضعفها.
4. المواضيع الرئيسية
-
الشعر مرآة الحضارة.
-
التوتر بين الإبداع الفني والمشاركة السياسية.
-
الأندلس نموذجا للتعايش والرقي الثقافي
-
مأساة الانحدار والمنفى.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
أسلوب يجمع بين النقد والشعر، ويعكس جمال الشعر الأندلسي.
-
كثرة الاستشهاد بأشعار ابن الخطيب.
-
كتابة تتميز بالأناقة الكلاسيكية والعاطفة.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
وقد حظي بقبول جيد في الأوساط الأدبية لمساهمته في إعادة اكتشاف التراث الأندلسي.
-
عمل مستخدم في الدراسات الأكاديمية حول ابن الخطيب والشعر الأندلسي.
-
وهذا يعزز رؤية عبد الكريم غلاب باعتباره جسراً بين التقليد الكلاسيكي والحداثة.
خاتمة :
في كتابه "عالم شاعر الحمراء"، يغوص عبد الكريم غلاب في عالم الشعر الأندلسي، متخذًا ابن الخطيب مثالًا يُحتذى به. يُحلل الكتاب شعره، وفلسفته الحياتية، وكتاباته السياسية، مُسلّطًا الضوء على ثراء الحضارة الأندلسية وهشاشتها في خضمّ أفولها. يُسلّط غلاب الضوء على عالمية رسالة ابن الخطيب وأهميتها في الفكر العربي الحديث.
أحمد بناني فقيد الأدب والوطنية
المؤلفون المشاركون:
-
عبد الكبير الفاسي
-
محمد الفاسي
-
أبو بكر القادري
طبعة فريدة من نوعها:
-
جماعة الرسالة الصحفية، الرباط (1981)
هذه المقالة بمثابة تكريم فكري يُهديه عبد الكريم غلاب لمواطنه وزميله أحمد بناني (1920-1979)، الكاتب والناشط الوطني المغربي. من خلال هذا النص، يتتبع غلاب حياة بناني، وإسهاماته في الحركة الثقافية والسياسية المغربية، والتزامه بالاستقلال. يجمع هذا العمل بين السيرة الذاتية، والتأبين، والتأمل في قيمة المشاركة الأدبية.
ملخص :
يُعيد الكتاب النظر في حياة أحمد بناني وأعماله، مُبيّنًا كيف جسّد شخصيته المزدوجة، الأديب والوطني المخلص. يُناقش عبد الكريم غلاب دوره في الصحافة، وكتاباته النقدية، ونشاطه السياسي. يُسلّط الكتاب الضوء على الخسارة التي شعر بها المجتمع المثقف المغربي بعد رحيله، مُؤكّدًا في الوقت نفسه أن إرثه الأدبي والأخلاقي لا يزال حيًا في الذاكرة الوطنية.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
نُشرت بعد وقت قصير من وفاة أحمد بناني، في سياق الحزن الفكري.
-
وهو جزء من " الكتابات - التكريمات " التي تساهم في التاريخ الثقافي المغربي وبناء الذاكرة الوطنية.
2. البنية والسرد
-
يعتبر العمل عبارة عن سيرة ذاتية فكرية وأخلاقية.
-
مزيج من السرد الزمني ( حياة بناني ) والتأملات الموضوعية (حول أعماله وقيمه).
3. الشخصية والرمزية
-
ويُقدم أحمد بناني كنموذج للمثقف الوطني، الذي يجمع بين الثقافة والالتزام والشجاعة.
-
وهو يرمز إلى الاندماج بين الأدب والقومية في المغرب المعاصر.
4. المواضيع الرئيسية
-
دور الكتاب في النضال من أجل الاستقلال
-
المشاركة الثقافية والسياسية واجب وطني.
-
ذكرى شخصيات فكرية رحلت.
-
العلاقة بين الأدب والصحافة والعمل الاجتماعي.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
نبرتك متواضعة ومحترمة ومجاملة.
-
أسلوب سردي بسيط، يتخلله أحيانًا غنائية جنائزية.
-
استخدام الحكايات والاقتباسات لتوضيح شخصية بناني.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
كان للعمل أهمية تذكارية في المقام الأول.
-
حظيت بقبول واسع في الأوساط الأدبية والوطنية المغربية.
-
ويعتبر قطعة مهمة لفهم مكانة الكتاب المغاربة في النضال الوطني.
خاتمة :
في مقاله "أحمد بناني فقيد الأدب والوطنية"، يقدم عبد الكريم غلاب عملاً ينضح بالذاكرة والوفاء. يُشيد المقال بزميله الرحالة، ويُبرز الدور الجوهري للمثقفين في بناء الهوية المغربية الحديثة. ويتجاوز هذا العمل كونه تكريماً، إذ يُقدم شهادة قيّمة على الترابط بين الأدب والسياسة في المغرب في القرن العشرين.
الماهدون ... الخالدون
نُشر لأول مرة في عام 1991
-
طبعات وانطباعات أبي رقراق، الرباط
طبعة أخرى:
-
منشورات صحيفة العالم، الرباط (1992)
هذا المقال عبارة عن معرض صور مُخصص لشخصيات فكرية وسياسية وثقافية من المغرب الحديث. يُسلّط عبد الكريم غلاب الضوء على شخصيات تركت بصماتها في التاريخ الوطني من خلال دورها التأسيسي في الفكر والنضال السياسي والإبداع الفني. يُمثّل العمل ذاكرة جماعية وتأملاً في الإرث.
ويتضمن تحليلات للشخصيات التالية:
-
محمد غازي ... المتنبئ بالاسقلال
-
محمد بن العربي العلوي ... شيخ الإسلام
-
محمد الفاسي ... الأستاذ الفقيه
-
عبد السلام بنونة ... المستقبلي
-
الهاشمي الفيلالي ... المناضل الصبور
-
عبد الله كنون ... المثقف الملتزم
-
المختار السوسي ... الفقيه الشاعر
-
أحمد بلافريج ... المفكر الاستقلالي
-
التهامي الوزاني ... صاحب الزاوية
-
عبد الرحيم بوعبيد ... المفكر السياسي
-
الحسن بوعياد ... الوطني الغيور
-
عبد الخالق الطريس ... المناضل الوحدوي
-
محمد بن عبد الكريم الخطابي ... بطل الريف
-
محمد بن الحسن الوزاني ... المناضل القومي
-
بوشتى الجامعي ... الأستاذ البدوي
-
المهدي بن بركة ... السياسي النابغ
-
أحمد مكوار ... شاهد العصر
-
محمد بن عبد الجليل ... المهندس السياسي
-
أبو بكر القادري ... مربي الأجيال
-
عبد العزيز بن إدريس ...المبشر الشهيد
-
محمد اليزيدي ... الحكيم الموجه
-
إبراهيم الكتاني ... المجاهد الصبور
-
علال الفاسي ... رائد الاسقلال
-
الحسن الثاني ... محرر الصحراء
ملخص :
من خلال سلسلة من الفصول، يُقدّم عبد الكريم غلاب شخصياتٍ مُختلفة من الحياة المغربية المعاصرة ( كتّاب، سياسيون، ناشطون )، مُتتبعًا مساهماتهم في بناء الوطن. ويُؤكّد على قدرتهم على إرساء أسس مستقبلٍ جماعي.
( المهيدون – الذين يعدون، الذين يمهدون الطريق) وخلودهم الرمزي
( الخالدون - الذين نجوا بأفكارهم وأعمالهم). المقال فعل اعتراف ونقل.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
صدر هذا الكتاب في وقت كان المغرب يسعى فيه إلى تعزيز ذاكرته الوطنية بعد عقدين من الاستقلال.
-
يندرج هذا العمل ضمن النوع التذكاري ويساهم في بناء صرح فكري مغربي.
2. البنية والسرد
-
هيكل مكون من صور متتالية.
-
مزيج من السرد السيرة الذاتية وتحليل الأعمال.
-
كتابة مجزأة، لكنها موحدة بخيط مشترك: استمرارية الذاكرة الوطنية.
3. الشخصية والرمزية
-
تجسد الشخصيات المختارة الاندماج بين الفكر والفعل.
-
وهي ترمز إلى الاستمرارية بين الماضي المؤسس ومستقبل الأمة.
-
يستخدم عبد الكريم غلاب هذه الصور كنماذج للمثقف الملتزم.
4. المواضيع الرئيسية
-
الذاكرة الوطنية ونقلها
-
الخلود الرمزي للرجال العظماء.
-
دور المثقفين والسياسيين في بناء الهوية المغربية.
-
العلاقة بين التراث والحداثة.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
كتابة رثائية ومديحية، ممزوجة بالجاذبية.
-
أسلوب واضح وسهل الوصول إليه، يهدف إلى الوصول إلى جمهور واسع.
-
التناوب بين التحليل الرصين والاحتفال الغنائي.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
تم اعتباره عملاً هاماً للذاكرة الثقافية والسياسية المغربية.
-
يستخدم كمرجع في الأوساط الأكاديمية والوطنية.
-
ساهم في نشر صورة عبد الكريم غلاب كمؤرخ للذاكرة الفكرية الوطنية.
خاتمة :
من خلال كتاب "الماهدون ... الخالدون"، يواصل عبد الكريم غلاب مشروعه في بناء ذاكرة مغربية جماعية. ومن خلال استحضار شخصيات مؤسسية، يُرسي عبد الكريم غلاب رابطًا بين الماضي والحاضر، مُرسخًا فكرة أن الأمة تُبنى أيضًا من خلال تكريم من مهدوا لها طريقها. وهكذا، يُقدم المقال نفسه كتحية تقدير، ودليلٍ لنقل الوطنية.
من اللغة إلى الفكر
نُشر لأول مرة في عام 1985
-
طبعات اتحاد كتاب المغرب، الدار البيضاء
طبعات أخرى:
-
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء (1993)
-
طبعات وانطباعات أبي رقراق، الرباط (2017)
يستكشف هذا المقال العلاقة العضوية بين اللغة والفكر في العالم العربي. يُشدد عبد الكريم غلاب على الدور الهيكلي للغة العربية في تشكيل الهوية الفكرية والثقافية. ويبحث في كيفية تحديد اللغة لقدرة تصور المعرفة، وإبداعها، ونقلها.
-
من المهد إلى النضج
-
عقدة اللغة
-
المغرب أمام إزدواجية اللغة وثنائيتها وتعدديتها
-
اللغة في مواجهات التحديات
-
اللغة والمسألة الثقافية
-
التعريب ودوره في حركات التحرر في المغرب العربي
-
الفرانكفونية الأنجلوفونية : سباق من أجل الهيمنة
-
من اللغة إلى الفكر من الفكر إلى اللغة
-
من اللغة إلى الحضارة
-
أزمة حضارة
-
أزمة الفكر المغربي
-
حضارة القلق والحرب لن تخلف حضارة السلم والاستقرار
-
القانون والحضارة العسكرية
ملخص :
يتناول الكتاب اللغةَ كمحورٍ للفكر. ويُبيّن عبد الكريم غلاب أن الأزمات الفكرية والثقافية في العالم العربي تنبع، جزئيًا، من الانفصال بين اللغة والفكر الحديث. ويدعو إلى إحياء اللغة العربية لمواكبة التقدم العلمي والفلسفي والاجتماعي. ويُقدّم المقال تحليلًا نقديًا للعلاقة بين التراث اللغوي وتحديات الحداثة.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
صدر هذا الكتاب في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، في فترة شهدت نقاشات مكثفة حول التحديث اللغوي والتعليمي في المغرب والعالم العربي.
-
المقال يتوافق مع العمل الذي يتأمل إصلاح التعريب ومسألة اللغة كناقل للحداثة.
2. البنية والسرد
-
هيكل جدلي منظم في فصول موضوعية.
-
نهج يجمع بين الفلسفية والاجتماعية اللغوية.
-
الاستخدام المتكرر للتاريخ والمقارنة مع التقاليد اللغوية الأخرى.
3. الشخصية والرمزية
-
ويتم التعامل مع اللغة العربية باعتبارها شخصية جماعية، وحارسة للذاكرة، ومحركاً محتملاً للفكر.
-
ويصبح رمزاً لقدرة العالم العربي على إعادة اختراع نفسه.
4. المواضيع الرئيسية
-
العلاقة بين اللغة والفكر.
-
الأزمة الثقافية والعلمية في العالم العربي
-
إصلاح اللغة والحداثة.
-
أهمية اللغة كأداة للتحرر والإبداع.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
أسلوب كثيف، جدلي، تعليمي في بعض الأحيان.
-
مزيج من المعرفة اللغوية والدفاع العاطفي.
-
استخدام الاستعارات لتوضيح حيوية اللغة أو ركودها.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
لقد أثار الكتاب الجدل الأكاديمي والسياسي حول إصلاح اللغة.
-
ويعتبر هذا الكتاب مساهمة فكرية كبيرة في التأمل حول مكانة اللغة العربية في العالم المعاصر.
-
وقد عزز هذا دور عبد الكريم غلاب كجسر بين الأدب واللغويات والفكر السياسي.
خاتمة :
في كتابه "من اللغة إلى الفكر"، يُقدّم عبد الكريم غلاب تأملاً عميقاً في اللغة كمفتاح للفكر والتقدم. يدعو إلى إحياء اللغة العربية لتصبح محركاً حقيقياً للحداثة، ويضع مقاله في مفترق طرق الثقافة والسياسة والتعليم. ويمثل هذا العمل خطوةً أساسيةً في مسيرته النقدية، خدمةً لقضية الإصلاح الفكري العربي.
... لا مفهوم للثقافة
نُشر لأول مرة في عام 1987
-
طبعات اتحاد كتاب المغرب، الدار البيضاء
طبعة أخرى:
-
دار المعرفة، الرباط (1999)
يستكشف هذا المقال أزمة تعريف الثقافة في المجتمعات العربية المعاصرة. يُحلل عبد الكريم غلاب المعاني المتعددة لمصطلح "الثقافة" والتوترات بين الثقافة الراقية والثقافة الشعبية والثقافة المستوردة. يُقدم هذا العمل نقدًا للخلط المفاهيمي الذي يعيق بناء هوية ثقافية حديثة ومتماسكة.
الثقافة هي الحياة
المثقف حي مادام ارتباطه بالثقافة يتطور تطور الثقافة نفسها.
مشروع الثقافة لم يصل إلى نهايته، ولم يتوقف منذ كان الإنسان. فليس لمشروع ثقافي أن يزعم أنه حقق الهدف، وليس لإنسان يتثقف - من المهد إلى اللحد - أن يزعم أنه وصل.
ربما كان العاملون في الحقل الثقافي هم أشقياء المتعلمين، الذين يسيرون دائما وراء سراب يحسبونه قريبا، وهو في الحقل الثقافي بعيد.
كثير من المثقفين يعرفون هذا، ويعيشون، بعناد، مع مشروع الثقافة، حتى ليقضون، ولم يحققوا منه ما يريدون.
سعداء بهذا الشقاء. فالمتعة الفكرية التي يحققونها، وهم يقرأون وهم يكتبون وهم يفكرون ويحللون وهم يجادلون ويحاورون، لاتعادلها متعة مادية ولامعنوية أخرى.
ظِماء دائما للمعرفة. كلما قرأوا وجدوا أنفسهم دون ما كان يجب أن يقرأوا، يجدون أنفسهم يستقبلون الجديد ويكتشفون القديم مما يجب أن يقرأوا. الحقل غني معطاء، ولو أعلن اليائسون عن ارتياعهم من زحف الصحراء. كلما فكروا أو كتبوا يجدون أنفسهم في الخطوة الأولى من الألف ميل، دون الخطوة الثانية بقية حياتهم.
يحاصرهم صخب الحياة في زوايا مهجورة معزولة. ومع ذلك يتصوفون، فيقنعون بالزاوية الضيقة المعتمة يستعينون بقنديل ديوجين مؤمنين بأنهم سيجدونها.
لولا المحاصرة والفقر والمكابدة وانصراف الضجة عنهم لمات المشروع منذ عهد أرسطو وأفلاطون.
يكاد المجتمع لايعترف بالثقافة والمثقفين ولو أخذ ينشئ لها في كل حكومة وزارة هزيلة تنفي التهمة عن الحكومة، أكثر مما تنشر للثقافة رداء، أو تغرس لها حقلا، أو توسع لها فضاء. في بلد عربي - غني ثقافيا، وكل شيء نسبي - ارتأى اتحاد الكتاب بمناسبة تأسيسه أن يقوم بزيارة مجاملة لرئيس الحكومة، فكان أول سؤال وضعه على نخبة المثقفين والكتاب :
- من أنتم ؟ وماذا تعملون ؟
دخلوا مع السيد الرئيس مدرسة رفع الأمية. وكانوا سعداء، وهو صادق في تجاهلهم.
وما يزال المثقفون يسيرون نحو السراب تحدوهم عزيمة لا تلين، وشكوى تنطلق أحيانا من حناجر مبحوحة، لا تطيق التجاهل والهجران والعزلة......
لا مفهوم للثقافة.
هذا الكتاب قد يكون نقطة في محيطها. ولكنه قد يحقق خطوة في المسيرة. ليس نتاج ارتجال أو مجرد عنوان تنضاف إلى عناوين. ولكنه يحاول. والذين أحدثوا حدثا في مسيرة الثقافة كانوا دائما يحاولون.
حسبي أن يربط صلة فكرية مع عدد من القراء، مهما تكن محدوديته. وسأكون سعيدا بأني حققت الكثير من خلال صلة فكرية مع فكر قارئ. لولا اعتزازي بهذا الذي قد يتحقق لما بذلت فيه من الجهد ما أقنعني بأني فعلت.
ملخص :
انطلاقًا من ملاحظة افتقار كلمة "ثقافة" إلى تعريف ثابت أو عالمي في العالم العربي، يُبيّن عبد الكريم غلاب كيف يُضعف هذا الغموض النقاش الفكري والسياسي. ويُسلّط الضوء على التناقض بين استخدامات الثقافة كأداة للتحرر وبين توظيفها أيديولوجيًا. ويقترح المقال إعادة النظر في الثقافة كعملية حية، متجذرة في اللغة والتاريخ والتجربة الجماعية، لكنها منفتحة على الحداثة والعالمية.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
نُشر هذا الكتاب في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، وهي فترة شهدت تأملاً مكثفاً في الأزمة الثقافية في العالم العربي.
-
تندرج هذه المقالة في إطار نقاشات ما بعد الاستقلال حول الهوية والتعريب والمواجهة مع الغرب.
2. البنية والسرد
-
التنظيم الموضوعي في أقسام تحليلية.
-
النهج الجدلي: تحديد التناقضات، وتفكيكها، ثم اقتراح الحلول.
-
التناوب بين الملاحظة النقدية ومقترحات الإصلاح.
3. الشخصية والرمزية
-
وتصبح "الثقافة" شخصية مجردة، غامضة، ورمزًا لأزمة الهوية.
-
فهو يمثل تراثًا مهددًا ومستقبلًا محتملًا.
4. المواضيع الرئيسية
-
أزمة في تعريف الثقافة
-
التوترات بين الأصالة والحداثة
-
الاستغلال الأيديولوجي للثقافة.
-
العلاقة بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية.
-
العالمية والخصوصية الثقافية.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
لغة مفاهيمية مثيرة للجدل في بعض الأحيان.
-
أسلوب تحليلي مستوحى من المراجع الفلسفية والاجتماعية.
-
استخدام نبرة ناقدة ولكن ملتزمة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
وقد أحدثت هذه المقالة صدى قويا في الأوساط الفكرية المغربية والعربية.
-
يتم استخدامه كأداة أكاديمية في المناقشات حول تعريف الثقافة.
-
وقد عزز هذا الكتاب مكانة عبد الكريم غلاب كمفكر ناقد في مجال الهوية الثقافية العربية.
خاتمة :
في مقال "لا مفهوم للثقافة..."، يُعالج عبد الكريم غلاب مباشرةً سؤالاً جوهرياً: استحالة إرساء مفهوم ثابت للثقافة في عالم عربي يمر بمرحلة انتقالية. يكشف المقال عن ثراء هذا المجال وهشاشته في آنٍ واحد، ويقترح مساراً للمضي قدماً قائماً على الاعتراف بالثقافة كعملية ديناميكية. يُعدّ هذا العمل محورياً، إذ يشهد على التزام عبد الكريم غلاب بتزويد الفكر العربي بأدوات نقدية للتفاعل مع الحداثة.
رهانات الفرانكفونية في علاقتها بمسألة التغريب والهيمنة
نُشر لأول مرة في عام 1989
-
طبعات اتحاد كتاب المغرب، الدار البيضاء
طبعة أخرى:
-
المجلس الوطني للثقافة العربية، الرباط (1999)
هذه المقالة تأمل نقدي في الفرانكوفونية كمشروع لغوي وثقافي وسياسي. يُحلل عبد الكريم غلاب تأثيرها في السياق المغربي والعربي، ويدرس تداعياتها الأيديولوجية والتربوية والهوية. يقع هذا العمل في تقاطع النقد الثقافي والتحليل الجيوسياسي.
ملخص :
يُسلّط عبد الكريم غلاب الضوء على تناقضات الفرنكوفونية : فهي أداة للتبادل والتأثير الثقافي، ولكنها أيضًا أداة لترسيخ النفوذ الاستعماري. ويتناول دورها في التعليم والدبلوماسية والإنتاج الثقافي في المغرب والعالم العربي. ومع إقراره بالمساهمة اللغوية والفكرية للغة الفرنسية، يدعو غلاب إلى فرنكوفونية قائمة على المساواة، لا على الهيمنة.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
نُشر هذا الكتاب في وقت أصبحت فيه الفرانكوفونية موضوعًا ساخنًا في المغرب، مع استمرار استخدام اللغة الفرنسية في التعليم العالي والإدارة.
-
تساهم هذه المقالة في النقاشات الفكرية العربية حول " ما بعد الاستعمار " اللغوي.
2. البنية والسرد
-
تنظيم واضح في الفصول: التعريف، القضايا، الانتقادات، وجهات النظر.
-
نبرتك التحليلية قريبة من نبرة المقال الجيوسياسي.
-
استخدام أمثلة ملموسة من الحالة المغربية.
3. الشخصية والرمزية
-
يتم التعامل مع الفرانكوفونية باعتبارها فاعلًا جماعيًا غامضًا: فهي بمثابة انفتاح وقيد في نفس الوقت.
-
وهو يرمز إلى الجدلية ما بعد الاستعمارية بين التراث المفروض والاستيلاء الإبداعي.
4. المواضيع الرئيسية
-
الفرانكوفونية وما بعد الاستعمار
-
علاقات القوة الثقافية واللغوية.
-
مكانة اللغة الفرنسية في التربية والفكر العربي.
-
الحاجة إلى حوار متوازن بين الثقافات.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
لغة واضحة، ناقدة، ومثيرة للجدل في بعض الأحيان.
-
أسلوب جدلي، قريب من الخطاب السياسي.
-
كتابة سهلة المنال، موجهة لجمهور واسع من المثقفين والناشطين.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
وقد أثار المقال جدلاً حيوياً في الأوساط الأكاديمية والسياسية.
-
ويعتبر مساهمة أساسية في النقاش حول الفرنكوفونية في المغرب العربي.
-
وأكد على دور عبد الكريم غلاب كمفكر في القضايا اللغوية والثقافية المعاصرة.
خاتمة :
في كتاب "رهانات الفرانكفونية في علاقتها بمسألة التغريب والهيمنة"، يقدم عبد الكريم غلاب تحليلاً واضحاً وملتزماً للفرانكوفونية، التي تُعتبر فرصةً وتهديداً في آنٍ واحد. يُمثل الكتاب معلماً بارزاً في نقاش ما بعد الاستعمار، داعياً إلى إعادة تعريف العلاقات اللغوية على أساس المساواة والاحترام المتبادل. ويشهد الكتاب على يقظة عبد الكريم غلاب الفكرية في مواجهة تحديات العولمة الثقافية.
علال الفاسي ينبوع فكري متجدد
المؤلفون المشاركون:
-
مصطفى محمد القباج
-
حسن أوريد
-
محمد القباب بن عبد الهادي
-
محمد السوسي
نُشر لأول مرة في عام 1990
-
طبعات اتحاد كتاب المغرب، الدار البيضاء
طبعة أخرى:
-
مطبعة المعرفة الجديدة، الرباط (2001)
هذه المقالة تأملات نقدية وتخليدية في شخصية علال الفاسي، زعيم حزب الاستقلال، المفكر ورجل الدولة. يراه عبد الكريم غلاب " نبعًا حيًا لا ينضب " للفكر المغربي الحديث. ويؤكد على إرثه الخالد، الذي لا يزال يلهم المثقفين والناشطين وصانعي السياسات.
ملخص :
يقدم الكتاب علال الفاسي ليس فقط كشخصية تاريخية، بل كمركز فكري متجدد . يؤكد عبد الكريم غلاب:
-
خصوبة وثراء أفكاره.
-
الطريقة التي لا تزال بها تأملاته تجد صدى لها في المغرب المعاصر.
-
استمرارية تفكيره في مسائل الإصلاح الاجتماعي والثقافة والسياسة والروحانية.
-
مكانتها كمصدر للشرعية الفكرية لأجيال عديدة.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
صدرت بعد وفاة علال الفاسي، في سياق تذكاري.
-
يهدف إلى ترسيخ إرثه الفكري في الذاكرة الوطنية.
-
جزء من مجموعة " الغلابين " المخصصة لتسليط الضوء على الشخصيات المغربية العظيمة.
2. البنية والسرد
-
التناوب بين التحليلات الموضوعية (السياسية والاجتماعية والثقافية) والمقاطع المثيرة.
-
رواية سلسة، تم تصورها باعتبارها احتفالاً بالفكر وليس سيرة ذاتية.
-
نبرة انتقادية وإشادية في نفس الوقت.
3. الشخصية والرمزية
-
ويظهر علال الفاسي كمنبع لا ينضب ( رمز الماء، والتجدد ).
-
شخصية بارزة في تاريخ المغرب المستقل.
-
رمز للاستمرارية، يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل.
4. المواضيع الرئيسية
-
الذاكرة الوطنية والتراث الفكري
-
الإصلاح الديني والثقافي.
-
الهوية المغربية والانفتاح العالمي
-
نقل الفكر.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
كتابة أنيقة ومثيرة ( استخدام مجازي للمصدر، الماء الحي ).
-
أسلوب يقع بين المقال والتكريم الأدبي.
-
لغة واضحة وسهلة الوصول، تتميز بالإعجاب.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
تم اعتباره نصًا رئيسيًا في الأدب التذكاري المغربي.
-
استخدم كمرجع أكاديمي وسياسي في دراسة علال الفاسي.
-
ترسيخ دور عبد الكريم غلاب كحارس وناقل للذاكرة الوطنية .
خاتمة :
في كتابه "علال الفاسي ينبوع فكري متجدد"، يقدم عبد الكريم غلاب مقالاً في ملتقى الذاكرة والنقد الفكري. بوصفه نبعاً نابضاً بالحياة لا ينضب، يرفع علال الفاسي إلى مصاف التراث المغربي اللامادي. يُجسّد هذا النص طموح عبد الكريم غلاب في الحفاظ على المبادئ التأسيسية للأمة المغربية الحديثة ونقلها.
البعد الإجتماعي في فكر علال الفاسي
لا توجد طبعة منفصلة لهذه المقالة؛ بل هي في الواقع مساهمة لعبد الكريم غلاب مدرجة في المجلد الجماعي "علال الفاسي، مصدر فكري متجدد".
-
ندوة خاصة بعلال الفاسي وإرثه الفكري (1980-90)
طبعة أخرى:
-
مطبعة المعرفة الجديدة، الرباط (2001)
يستكشف هذا المقال دور البُعد الاجتماعي في فكر علال الفاسي، الشخصية المحورية في الحياة الفكرية والسياسية المغربية في القرن العشرين. ويؤكد عبد الكريم غلاب أن فكر أستاذه لم يقتصر على السياسة أو الاستقلال الوطني، بل امتد إلى رؤية اجتماعية شاملة، شملت مجالات التعليم والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي.
ملخص :
يسلط النص الضوء على كيفية دمج علال الفاسي:
-
العدالة الاجتماعية كمبدأ أساسي لالتزامه.
-
تفسير حديث للإسلام، يركز على التضامن والكرامة.
-
أهمية التعليم والثقافة في تحرير الجماهير.
-
دور الدولة والمؤسسات في إعادة توزيع الثروة.
-
رؤية حيث التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي لا ينفصلان.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
جزء من تأملات " ما بعد الاستقلال ".
-
يهدف إلى إظهار أن علال الفاسي لم يكن سياسيًا فحسب، بل كان أيضًا مفكرًا اجتماعيًا.
-
ويشكل مساهمة في التأريخ الوطني.
2. البنية والسرد
-
تحليل موضوعي مقسم حسب المحاور (العدالة، المساواة، التعليم، التضامن).
-
أسلوب رصين وتوضيحي، قريب من أسلوب المقال الأكاديمي.
3. الشخصية والرمزية
-
يبرز علال الفاسي كمنظر اجتماعي صاحب رؤية ثاقبة.
-
رمز للإسلام الإصلاحي المتجذر في العدالة الاجتماعية.
4. المواضيع الرئيسية
-
العدالة الاجتماعية والمساواة.
-
التعليم والتدريب المدني.
-
العلاقة بين الدين والتضامن.
-
القومية الاجتماعية والاقتصادية.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
كتابة واضحة وجدلية.
-
أقل استعارة من المقالات الأخرى لعبد الكريم غلاب، وأكثر تحليلاً.
-
التركيز على الاقتباسات المباشرة والإشارة إلى علال الفاسي.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
يعتبر هذا الكتاب نصا أساسيا لفهم الفكر الاجتماعي لعلال الفاسي.
-
يُستشهد به كثيرًا في الأعمال المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي في المغرب الحديث.
-
وقد ساهم ذلك في ترسيخ صورة علال الفاسي كمفكر عالمي، وليس مجرد سياسي.
خاتمة :
في مقاله "البعد الاجتماعي في فكر علال الفاسي"، يُظهر عبد الكريم غلاب البعد الاجتماعي العميق لفكر أستاذه. يربط هذا المقال بين التاريخ السياسي والاجتماعي للمغرب، كاشفًا أن علال الفاسي اعتبر الاستقلال الوطني جزءًا لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية والتقدم الإنساني.
نحب الحياة
... كتاب كل شابة ... كل شاب ... كل رجل ... ك�ل امرأة
طبعة فريدة من نوعها
-
صحافة النجاح الجديدة، الدار البيضاء (2005)
هذه مقالة فلسفية وإنسانية، يُعبّر فيها عبد الكريم غلاب عن تمسكه بالحياة كقيمة كونية. بعيدًا عن كونها مجرد صرخة حيوية، يهدف النص إلى أن يكون تأملًا في معنى الوجود، وفي كرامة الإنسان، وفي علاقة العرب والمسلمين بالحداثة والتقدم.
-
الحياة
-
أنت ... أنا ... هو ... نحن ...
-
كل شيء حي ... والحياة أمانة ...
-
تحبه ... يحبني ... نحبك ...
-
أنت أب ...؟ أنت أم ...؟
-
آنستي ... أو يا سيدتي
-
الجنس اللطيف
-
الرجل
-
قبيلتي ... مدينتك ... شعبنا ...؟
-
الحياة تبدع والإنسان يؤدي
-
يبحث عن لقمة عيش
-
تريد أن تكون غنيا
-
ثقافة العمل
-
صديقك من صدَقك ، لا من صَّدقك
-
اقرأ ... يقرأ ... لا يقرأون
-
مجتمع الأحرار
-
شاب في الثمانين
-
إنا عرضنا الأمانة ... وحملها الإنسان
-
فأما الذين سعدوا
-
غصن الزيتون
-
ثقافة العقل ... ثقافة الروح
-
المواطنة
-
الأنانية ... والغيرية
-
التضامن
-
الشيخوخة
-
ابتسمي ... تبتسم لك الدنيا
-
شموع مضيئة
ملخص :
في هذا المقال عبد الكريم غلاب:
-
وهو يدافع عن فكرة أن الحياة هي هدية مقدسة يجب الحفاظ عليها.
-
فهو يجمع بين حب الحياة والنضال من أجل الحرية والعدالة والكرامة.
-
ينتقد خطابات الموت واليأس والقدرية.
-
ويؤكد أن التفاؤل والإبداع والثقافة هي المحركات الحقيقية للتقدم.
-
ويستند إلى التراث العربي والإسلامي والمراجع العالمية للتأكيد على فلسفة الانفتاح.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
نُشرت في سياق التوترات الاجتماعية والسياسية في المغرب والعالم العربي.
-
جزء من حركة الأدب الإنساني العربي في ثمانينيات القرن العشرين.
2. البنية والسرد
-
مقال حر، منظم حول الأفكار والتأملات.
-
لا يوجد تقسيمات صارمة، بل تقدم جدلي سلس.
3. الشخصية والرمزية
-
" الإنسان " بشكل عام هو محور الاهتمام، وهو رمز للكرامة والمرونة.
-
" الحياة " تصبح رمزًا للنضال ضد الظلم واليأس.
4. المواضيع الرئيسية
-
الإنسانية والكرامة الإنسانية.
-
التفاؤل في مواجهة الشدائد.
-
القيم العالمية للحرية والعدالة.
-
المصالحة بين التقليد والحداثة.
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
كتابة سلسة، جدلية وغنائية.
-
استخدام الاستعارات الحيوية.
-
نبرتك دافئة ومحفزة.
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
تم استقباله باعتباره نصًا يقدم الأمل في وقت الأزمة.
-
اقرأ كمساهمة في الفكر الإنساني العربي.
-
يحظى هذا الكتاب بالتقدير لوضوحه وأسلوبه الأدبي، على الرغم من أنه يظل تأمليًا أكثر من كونه توضيحيًا.
خاتمة :
في كتاب "نحب الحياة"، يقدم عبد الكريم غلاب مقالاً إنسانياً وعالمياً، حيث يصبح حب الحياة قوة مقاومة وأمل. ويمتد هذا النص بالتزامه الأدبي والسياسي بالتأكيد على أن كل إصلاح وتقدم يجب أن ينبع من إيمان راسخ بقيمة الوجود الإنساني.
أزمة المفاهيم وانحراف التفكير
نُشر لأول مرة في عام 1998
-
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
طبعات أخرى:
-
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، (2004 و2010)
انطلاقًا من أزمة المفاهيم وغموض الفكر، وهما جزء من تباينات العالم العربي، يحاول المؤلف إعادة النظر في الاختلافات الجوهرية في مفاهيم الإشكاليات التي أدت إلى عجزنا عن السير نحو وحدة الرأي والعمل، وبالتالي إلى استحالة تحقيق الوحدة العربية. ومن هذا المنطلق، حاول المؤلف، من خلال هذا الكتاب، معالجة بعض هذه المفاهيم بموضوعية وفكرية، لتصحيح ما يؤثر منها على بعض جوانب الحياة العامة. أي أنه مقال لتحليل أسباب هذا الانحراف، لإيجاد سبل توجيهه، وفقًا لوجهة نظر المؤلف.
ملخص :
يطور عبد الكريم غلاب فكرة مفادها:
-
إن الفكر العربي يعاني من أزمة مفاهيمية تمنعه من بناء المعرفة الصلبة.
-
ويتم استخدام مصطلحات مثل الديمقراطية والحرية والحداثة والهوية بطريقة متناقضة وتلاعبية.
-
إن الارتباك المصطلحي يؤدي إلى انحراف في التفكير الجماعي ويمنع التطور الاجتماعي.
-
ويدعو إلى العودة إلى الوضوح المفاهيمي، وإلى إعادة صياغة متجذرة في التاريخ والثقافة العربية.
تحليل :
1. سياق النشر ومكانته في التاريخ الأدبي
-
وهو جزء من النقاش العربي في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين حول الحداثة والهوية.
-
ويشكل هذا الكتاب ردا نقديا على الأزمة الأيديولوجية والثقافية في العالم العربي.
2. البنية والسرد
-
تم تنظيم الكتاب موضوعيًا، حيث يتناول كل فصل مفهومًا رئيسيًا.
-
أسلوب توضيحي وتحليلي، يتميز بالاهتمام بالدقة الفكرية.
3. الشخصية والرمزية
-
لا توجد شخصيات، ولكن المفاهيم نفسها تصبح ممثلين وموضوعات للنقد.
-
رمز للنضال من أجل الوضوح وضد التلاعب الأيديولوجي.
4. المواضيع الرئيسية
-
أزمة الفكر العربي.
-
الاستخدام المتناقض للمفاهيم الحديثة
-
الهوية والأصالة والحداثة.
-
دعوة لإصلاح اللغة الفكرية
5. الأسلوب الأدبي والجماليات
-
لغة واضحة ولكنها كثيفة ومثيرة للجدل في بعض الأحيان.
-
استخدام أمثلة ملموسة لتوضيح التجريد.
-
ناقدك، الذي يتسم بالجدل الدائم ضد "التجاوزات".
6. الاستقبال النقدي والنطاق
-
حظيت بقبول واسع في الأوساط الفكرية المغربية والعربية.
-
وأثارت نقاشات حول اللغة العربية والمصطلحات والحداثة.
-
يُستشهد به دائمًا في الدراسات حول الأزمة الثقافية في المغرب.
خاتمة :
في مقاله "أزمة المفاهيم وانحراف التفكير"، يتناول عبد الكريم غلاب الأزمة الفكرية في العالم العربي مباشرةً، طارحًا السؤال المحوري المتعلق بالوضوح المفاهيمي. يكشف المقال عن التزامه الراسخ بالدفاع عن فكرٍ موضوعي، نقدي، وبناء، قادر على تجاوز سوء الفهم المصطلحي لإعادة بناء حداثة عربية مستقلة.
تُشكّل مقالات عبد الكريم غلاب الأدبية والفكرية عملاً متكاملاً يُجسّد رؤيته لمغرب حديث، متجذّر في هويته الثقافية ومنفتح على الكون. يجمع غلاب في هذه المقالات بين النقد والذاكرة والتربية لبناء فلسفة ملتزمة.
وتشكل هذه النصوص اليوم شهادة قيمة على المناقشات الفكرية المغربية في القرن العشرين، وأساسا لفهم تطور الفكر العربي المعاصر.